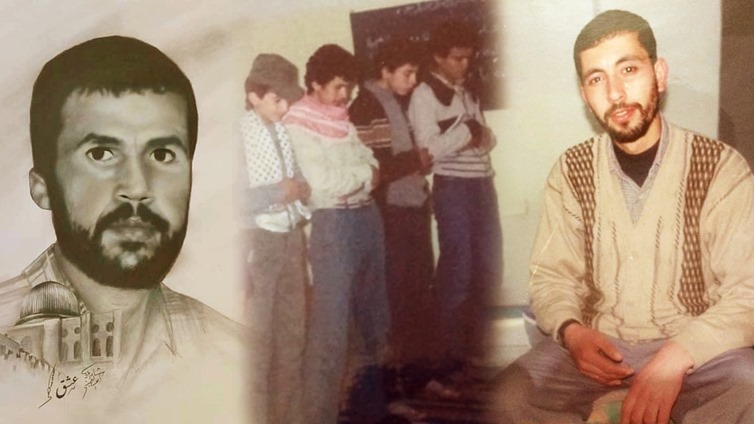كيف صعدت هذه الهبّة الشعبية وتضمّنت مشاركة واسعة التحمت فيها القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، محولةً جغرافيا التقطيع والتقسيم إلى جغرافيا التنوع في أدوات وتكتيكات واستراتيجيات المواجهة؟ سؤال تحاول ميرون جرار الإجابة عليه في هذا المقال.
اللغز والولادة الكثيفة
في أحيانٍ كثيرةٍ تخون اللغةُ الحدثَ، فهي تختزل المعقد والمتداخل والمتنوع وتحاول ترتيبه بشكل مفهوم ومنطقي متسلسل، تحوّل ما يُحرّك العضل إلى قطع مدروسة من المنطق واللغة. لهذا ما يكون الشعر أو الأغنية أقرب إلى التقاط اللحظة الثورية بكلّ زخمها، وبما تُحيل إليه من شعور عارم بالقوة والفعالية لحظةَ ظهورها وانكشافها على العلن، أي لحظة ولادتها.
لم يكن هذا الشهر عادياً، وإن بدأ على وقع أصوات رئيس الحكومة “نتنياهو” متبجّحاً بكوْن العام المنصرم -أي عام الجائحة والعزلة وعام تباعد الأجساد- الأكثر أمناً على دولة الاحتلال. بل رافقت تصريحاته الانتخابية استعراضاً لما حققته “إسرائيل” من تكوين علاقات “استراتيجية” في المنطقة العربية تخللها توقيع اتفاقيات مع بعض الدول في الخليج العربي والسودان والمغرب دلالة معنوية ونفسية على إمكانية تطبيع وجود الكيان وتحصين وجوده في قلب العالم العربي والإسلامي.
إذن، كيف تهاوت رؤية نتنياهو بهذه السرعة؟ بل وكيف صعّدت هبّة شعبية عارمة لم تشهدها فلسطين منذ انتفاضة الأقصى، تضمّنت مشاركة واسعة التحمت فيها القرى والبلدات والمدن على طول الضفة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل والشتات، وحولت جغرافيا التقطيع والتقسيم والمعازل إلى جغرافيا التنوع في أدوات وتكتيكات واستراتيجيات المواجهة؟
تيارات التعاون مع الاستعمار تتخبّط
ولدت الهبّة العارمة بعد وصول مشاريع التعاون مع الاستعمار إلى حائط مسدود فقدت فيه القدرة على خلق سردية واضحة المعالم، وأصبحت تعاني من تخبُّط على مستوى قدرتها على الإبقاء على الوضع القائم. ما نشهده هو انفكاك ما بين الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني وبين النخب السياسية التقليدية خاصّة في الضفة الغربية، حيث تشكلت فيها منذ نهاية انتفاضة الأقصى نخبة سياسية واقتصادية تستقوي بالعدو، وتبني أساس وجودها على هذا الاستقواء؛ إذ حوّلت ركام الثورة الفلسطينية، إلى فزّاعة تُوظّف في عملية تسويغ وتبرير التعاون الأمني والاقتصادي مع العدو في الحاضر. وهنا تحديداً تجلّت خطورة مشروع الحكم الذاتي الذي تُوّج بسيطرة تيارات التعاون مع العدو على السلطة الفلسطينية تحت شعار البراغماتية العاجزة وبناء الدولة، خاصّة بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، وبعد نجاح الاحتلال في إضعاف تيارات المقاومة في الضفة الغربية في خضمّ انتفاضة الأقصى (2000-2005)، إمّا من خلال التصفية الجسدية أو الاعتقال، أو من خلال تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكثر ما يُدلل على عمق الاختلال الأخلاقي في بُنية السلطة الفلسطينية الحالية هي حالة الشيزوفرينيا التي تعتلي خطابها؛ إذ من جهة تقمع البنى الاجتماعية الثورية التي تسعى إلى تطوير قدرة المجتمع على المقاومة أو تلك التي تخلق سبل الفعل الثوري في الحاضر، ومن جهة أخرى تتغنّى بماضٍ ثوري. لم تعد حتى لعبة التخفّي تحت غطاء الانقسام السياسي بين حماس وفتح مُقنِعة، بل إن صناعة العداء المُطلق مع حركات الإسلام السياسي الحاملة لمشروع المقاومة هو بالتحديد ما تحتاجه السلطة في منحها مجالاً واسعاً من الغطاء السياسي في عملية إعادة تعريف العدو من الصديق، وإسقاط العداء عن العلاقة مع الاحتلال وترحيله إلى الخصم السياسي الداخلي.
وهنا تحديداً استطاعت القيادات التي كانت تدور في فلك الرئيس الراحل ياسر عرفات من تشكيل طبقة اجتماعية تضمّنت رؤساء الأجهزة الأمنية، ورجال أعمال، ونخباً سياسية وثقافية انقضّت على فرصة إعادة هيكلة السلطة، وتحويل السلطة إلى الجدار الأمني الأول والحاجز السياسي الأساس في قدرة المجتمع الفلسطيني، خاصّةً في الضفة، على تطوير أدوات المواجهة وقدراته على المقاومة. ولكن على مدى العشر سنوات الماضية كانت السلطة قادرة على تغليف التحوّل المركزي في بنيتها ووعيها بدورها ككيان وظيفي أمني من خلال ادعاء امتلاكها مشروع “بناء دولة”، واتهام أيَّ معارَضة لها أنها معارَضة خارج الصف الوطني؛ أي تمثّلت نجاعتها أنها قادرة على تسويغ التعاون مع الاستعمار على أساس خطاب سياسي وطني.
بالفعل، فإنّ كل القوى السياسية التي حاولت الوصول إلى صيغة تفاهم مع هذه النخب وسعت لإعادة بناء برنامج سياسي مُوحّد، أو الوصول إلى حدّ أدنى من النقاط المشتركة معها، وقدمت تنازلات جمّة بما فيها القبول بعقد انتخابات غير تزامنية، وصلت إلى طريق مسدود معها، فما كان من قيادة السلطة سوى تأجيل الانتخابات. وكأنّ السلطة في لحظة استعلاء تعتقد أنها قادرة على التفرد بالقرار دون أيّة عواقب تُذكر. فقد دخلت الجبهة الشعبية وحماس وغيرها من قوى المعارضة الانتخابات، مُعتقدة أنها تستطيع اجتراح أدوات تغيير من داخل المنظومة، ولكنها قوبلت بتأجيل يهدف إلى حماية مشروع الحكم الذاتي القائم على التعاون مع المستعِمر.
ما نراه في السنوات القليلة الماضية تسارع عملية تعرية السلطة الفلسطينية وتيارات التعاون مع الاحتلال إجمالاً، وتسارع عمليات انكشافها على حقيقتها وبالتالي أيضاً بحث المجتمع عن آليات مقاومة ثنائية تتضمّن الاشتباك مع الاحتلال ومع السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي. أمام تخبّط وتلبّك يُعرّي التيارات المتصارعة على خلافة الرئيس الحالي، تظهر علامات التخبط في كل قرار تتخذه تلك النخبة حتى أصبحت تراوغ نفسها، وتختلف أزمات لتعود إلى المربع ذاته، أي مربع الاستمرار بالتعاون الأمني والاقتصادي مع العدو.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى وصول النخب السياسية في الداخل الفلسطيني المحتل إلى المربع نفسه، بعد أن وصلت مشاريع التوصية والتحالف مع التيارات الصهيونية في تشكيل الحكومات “الإسرائيلية” إلى مداها النهائي، أي إلى تخبّطها أمام الانقسامات ما بين التيار الإسلامي من الأحزاب المشاركة في الكنيست وما بين الأحزاب العلمانية. فضلاً عن اصطدامها بحقيقة الدور الذي يُعزى إلى القيادات الصهيونية، كنُخب وسيطة تلعب أدواراً أمنيةً بمنطقٍ اجتماعي، وفي ظلّ فشلها على معالجة إشكاليات اجتماعية كُبرى كتفشّي الإجرام في الداخل المحتل والعنف الداخلي الذي كان يشهد تزايداً ملحوظاً. فما كان منها سوى تصدير خطاب الحاجة لتدخّل أمني من قبل الشرطة لحلّ إشكالية الجريمة.
لم تعمل تلك القوائم العربية في الكنيست على اجتراح نموذج مجتمعي مُشتبك بواقع الحياة اليومية في الداخل، بل في ظل تفشّي الإجرام في الداخل والعنف الداخلي الذي كان يشهد تزايداً ملحوظاً، رهنت تلك القوائم نفسها لخطاب عاجز يستنجي بالشرطة والمؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، وأمام هذا التخبّط على مستوى العلاقة مع المجتمع، بدأت حلول إشكالية العنف تخرج من القرى والبلدات العربية دون مساهمة حقيقية من الأحزاب العربية والقوائم المختلفة العاملة في مجال التمثيل السياسي البرلماني، وتكلّل ذلك في حراك “الشرطة أصل الورطة” في أم الفحم.
ساهم هذا النموذج في الإعلاء من أهمية المواجهة حتى تلك التي تأخذ شكلاً منخفضَ الوتيرة في تصدير إشكالية الإجرام إلى الشرطة والمؤسسة الاستعمارية نفسها، وتشكيل نموذج يُحاكى اليوم في العديد من البلدات العربية. فحلّ الإشكاليات التي تواجه مجتمعنا لا يمكن أن تأتي ممّن يحاول اقتلاع علاقتنا مع الأرض، بل ينبع من الاشتباك معه وليس الاستجداء به.
واتضح أن إعادة ضبط بوصلة العنف في وجه المؤسسة الاستعمارية أسهل طريقة لعلاج ظاهرة العنف الداخلي، ففي لحظات المواجهة أيضاً لحظات إعادة تعريف العدو من الصديق، ولحظة شعور المجتمع بفعاليته وقدرته على حلّ إشكاليته دون تدخّل المؤسّسة الاستعمارية، وإنّما في مواجهة معها.
وما زالت القوائم في الداخل المحتل تترنّح في موقعها، تلعب اللعبة نفسها على مدى أربعة انتخابات متتالية وفاقدة للقدرة على المبادرة على مستوى حل الإشكاليات الاجتماعية المتعاظمة في الداخل، خاصّة تلك المرتبطة بتعاظم العنف الإجتماعي الداخلي والذي يتخذ طابعاً منظماً. وما زالت ترهن وجودها ودورها على العلاقة مع المؤسسة الاستعمارية.
لم يحدث انكشاف الطبقة والنخب الحاكمة في الضفة والداخل المحتل في لحظة واحدة، ولكنه أخذ شكل انبثاق، ووُلد من إطالة عمر مشروع السلطة الذي لم يعد قادراً على الربط أو خلق الصلة بين الحاضر والمستقبل والماضي، أي لم يعد قادراً على مداعبة المخيلة المستقبلية لمجتمع ما زال يترنّح داخل علاقة استعمارية تفرض عليه دوماً التفكير والوعي لإمكانية اقتلاعه من الأرض. ولم يعد يستطيع استحضار الماضي في عملية تعريف شرعيته السياسية في الحاضر. ولعبت أيضاً حراكات اجتماعية وسياسية وهبّات متلاحقة دورها في تفكيك وتعرية السلطة الفلسطينية وتيارات التعاون مع الاحتلال إجمالاً على مدى عقد وأكثر من المواجهة مع السلطة.
لهذا عندما أعلنت السلطة عن إقامة انتخابات تفاءل البعض من إمكانية تحقيق انتصار سياسي على النخبة الحاكمة من خلال صندوق الاقتراع، ولكن في ظل الصراع المتصاعد بين شخوص المنظومة السياسية والطموحات الشخصية لمن يدور في فلك الرئيس الحالي، أبو مازن، تهاوى مشروع الانتخابات، ما أدى لتعزيز الشعور عند قوى المقاومة التي اختارت النزول في الانتخابات بعمق تغلغل حالة العجز والانتفاع الاقتصادي عند النخبة هذه، وخوفها الذي يقترب من حالة “التوتّر الوجودي” تجاه أيّة خطوة قد تؤدّي إلى زعزعة سيطرتها على البيروقراطية الحكومية وعلى الأجهزة الأمنية وبالتالي فقدان دوره كبنية وسيطة ترعى مصالح الاحتلال.
“أهلا بيك في ولاد القدس”
تقول كلمات أغنية “بلاتنوم” التي قدمها لنا “ضبور وشب جديد”:
“أهلاً فيك بولاد القدس، بندبّر حالنا نحل اللغز”.
تشكل هذه الكلمات المكثفة جرعة غنائية أقرب للنبوءة حول مجريات الأحداث التي ظهرت مع بدايات شهر رمضان في القدس تحديداً. وليس غريباً على القدس المتحرّرة من وطأة بُنى الوساطة والتعاون، والتي تشع مركزيتها الدينية والاجتماعية على كافة جغرافية فلسطين أن يأتي حل اللغز منها. فهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها القدس موقعاً لولادة اللحظة الثورية، والتمرُد الجمعي على الاحتلال وأعوانه.
وُلدت المواجهة في لحظة الفقدان، أي في لحظة خراب العلاقة اليومية مع فضاء المدينة من خلال وضع الاحتلال حواجز حديدية في قلب العصب الاجتماعي اليومي لـ “ولاد القدس” المتمثل في منطقة باب العامود؛ حيث غالباً ما يكون خراب الأشياء تذكيراً لنا بأهميتها.
ترافق وضع الحواجز مع تشكل الحشود التلقائية في ظل إيقاع الوقت الذي يفرضه شهر رمضان والتجمعات التي تتحصّل بعد الإفطار دون الحاجة إلى آليات تنسيق مسبق. واتخذت المواجهات بشكل عام شكلاً ليليلاً. وكما يقول الأستاذ خالد عودة الله، استطاع الفلسطيني امتلاك الليل في هذه الهبّات المتتالية. ففي شهر رمضان، تبدأ الحياة الاجتماعية بالليل، أي عقب الإفطار، لهذا تكثفت المواجهة في الليل في القدس والداخل وفي كلّ بقاع فلسطين بهذه اللحظة بالذات.
التفّت القدس بغالبية شرائحها الاجتماعية حول إزالة الحواجز الحديدية، واستطاعت في وقت قصير فرض تراجع من قبل الاحتلال، من خلال إخلاء ساحات باب العامود من تلك الحواجز. ما جسّده “ولاد القدس” على المستوى التكتيكي من القدرة على خلق جدار بشري ليّن ومنتشر بكثافة في محيط منطقة البلدة القديمة والأحياء الملاصقة فيها، وكان لهذه التجربة أهميتها في خلق الوعي بإمكانية الفعل الذي لن يكتفي بتحقيق تراجع على مستوى إزالة الحواجز الحديدية، بل أيضاً إمكانية استمراره في إفشال -ولأول مرة منذ تاريخ نشأة “مسيرة الأعلام” في “عيد توحيد مدينة القدس” أي منذ عام 1998- مرور تلك المسيرة من عصب الحركة الأساسي لأهل المدينة، أي باب العامود.
لم تعد عملية تشييد هذا الجدار البشري بحاجة إلى جهدٍ كبيرٍ، بل أصبح من السلاسة إذ يمكن تشييد الجدار بلحظات، ليحضر ويغيب، ويعود يظهر عند الحاجة. وبالرغم من سلاسة وبساطة التشكل إلا أنه يعبر عن حالة وعي متقدم بما يمكنه الحشد والأجساد المرتبطة عضلياً وعلى مستوى الوعي الجمعي من تحقيقه في وجه جهاز شرطة يكاد يكون الأكثر عسكرة والأكثر شراسة بالعالم. بهذا المعنى، تحول أبناء القدس من مُطارَدين إلى مجموعات صيد تكرّ وتفرّ على مدى المدينة وفضاءاتها العمرانية والاجتماعية.
بتعابير ما حققه “ولاد القدس” إعادة اكتشاف لقدرة التنظيم الذاتي على خلق أدوات فعّالة في المواجهة مع الاحتلال، اتخذت بهذه المرحلة شكل الجدار البشري الليّن والمتناثر، وتارة أخرى يأخذ شكل جرف بشري منساب ومًتراصّ، وتارة أخرى يختفي بين البيوت والأحياء، ويعود، في عملية تكرار جعلت من الشرطة أهدافاً وحولت سؤال الهروب أو البقاء، وسؤال التراجع أو التقدم إلى سؤال المؤسسة الاستعمارية ومن وراءه الآلاف من المستوطنين. وأظهرت أننا نحن من نصقل اسئلتهم.
في المواجهة مع إحدى أهمّ التظاهرات التي يقوم بها التيار الصهيوني الديني بدعم كامل من المؤسسة الاستعمارية برمّتها، توالت الانتصارات وتراجع الاحتلال، أولاً من خلال تأجيل قرار المحكمة بما يتعلق بقضية حي الشيخ الجراح، وثانياً من خلال منع “مسيرة الأعلام” من اقتحام الأقصى وصولاً لمنعها من اقتحام العصب الاجتماعي المرتبط باب العامود والبلدة القديمة، التي تشكل بالنسبة لتلك التيارات الصهيونية مغزى وهدف التظاهرة بالأساس، أي قدرتها على المرور من وسط باب العامود دون مقاومة.
بالفعل، في لحظات تفككت أحلام رأس حربة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، أي التيار الصهيوني الديني، ولم تستطع المسيرة المرور عبر باب العامود، واندثرت في ظل صليات الصواريخ التي انطلقت من غزة صوب القدس. وبهذا تحول النصر إلى نصرين، نصر إزالة ما تم تخريبه في بداية شهر رمضان، أي المعيقات الحديدية على أدراج باب العامود، إلى نصر إعادة بناء حدّ جديد في العلاقة مع الاستعمار وإفشال مخطّط الاستيلاء على البيوت في الشيخ جراح وتأجيله، كما إفشال مخطط الاحتفال بيوم القدس باستعراض راقص ومليء بالرمزيات. وكان لهذا الحدّ رمزيته العالية بوضع الشرطة شاحنات سدّت مداخل منطقة باب العامود في وجه المستوطنين.
المقاومة في غزة
منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 والمقاومة تحاول اجتراح معركة تحرّرها من معادلة المال وبعض مشاريع البنى التحتية مقابل الهدوء، بل تبحث عن آلية اشتباك تدخلها في مواجهة على مستوى فلسطيني جامع، وغير محصور برفع بعض عناصر الحصار المفروضة على قطاع غزة، أو استخراج تنازلاتٍ من العدو مرتبطة بمستوى الحصار.
استراتيجية الاحتلال في غزة قائمة على إماطة أمد الهدوء، فالهدوء يلعب في صالحها، خاصة وأن الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحصار ينهش المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، دون تكلفة حقيقية على الاحتلال إلا في سياق المواجهة نفسها. ولا بدَّ من التذكير أنّ الفعل العسكري ومجرد التلويح به كان ذا أهمية كبرى في اجتراح انتصارات القدس المتتابعة، بل أيضاً ساهم في توسعة رقعة المواجهة لتشمل مئات نقاط الاشتباك في الداخل والضفة الغربية. وبالطبع المواجهة في غزة تأخذ شكلاً عسكرياً متقدماً، مبنيّاً على حوار التكتيك العسكري، بينما في سياقات أخرى خاصّة في القدس والداخل فهو ينبع من حميمية الاشتباك دون عوازل وفواصل جغرافية كثيرة، أي دون طبقات من الجدران الحقيقية وتلك المجازية.
استطاعت المقاومة في غزة خلال أيام معدودة إظهار التطور الملحوظ في التوظيف التكتيكي والتنوع الصاروخي التي تمتلكه بما فيه بحوزتها، وكان في حوار الصاروخ مع القوة الجوية، معادلة استطاع خلق حالة رعب متبادل، لم تقتصر على صفارات الإنذار وتعدّته إلى الأضرار الملموسة وحالة الهلع في العصب الديمغرافي والاجتماعي للكيان، أي في منطقة “غوش دان”. حالة الإرباك على المستوى الاجتماعي الصهيوني تتراكم، فهي من جهة تخوض صراعاً داخلياً يقترب من احتراب أهلي أدّى إلى أربعة انتخابات متتالية، تتضمن تفكيك الائتلاف اليميني الحاكم منذ عام 1977، ويؤدي اليوم إلى إضعاف الثقة بين المجتمع والقيادة السياسية والعسكرية للعدو. ما يحصل يتعدى أثر الصاروخ المباشر ويكشف عن مستويات مختلفة حول مدى عمق التحولات في المجتمع الصهيوني، بما فيه الفشل في إنتاج قيادات سياسية جادة.
كل دخول إلى الحرب له ثمنه الغالي، ففيها تضحيات مهولة على مستوى المقاومة نفسها وحاضنتها الاجتماعية المباشرة. ولكن في هذه المعركة لم تقاتل غزة وحدها. غزة قاتلت في خضم انتصارات القدس، وفي ظل إحدى أكبر الانتفاضات في الداخل المحتل. في كتاب يعقوب بيري “الآتي لقتلك”، يشير رئيس الشاباك السابق إلى خوف المؤسسة الأمنية الصهيونية من أن يرافق الحرب مع دول الطوق -الأردن ولبنان وسوريا ومصر- انتفاضة في الداخل المحتل، تشل حركة الطرق والحياة في الداخل، لما لهكذا نوع من الانتفاضات من قدرة على تخريب المنظومة اللوجستية للإمداد، خاصة في إغلاق الشوارع. السيناريو هذا تحقق اليوم، الكابوس هذا تحقق اليوم. انتفاضة عارمة في قرى ومدن الداخل، يرافقها صواريخ تنطلق من كل صوب، مؤسساً لها جدران القدس البشرية.
عندما دخل الكيان هذه المعركة في غزة أعلن منذ البداية أنها ستكون معركة دون دخول بري، أي أنها ستكون حرباً دون معركة، ولا يعني هذا أن تبقى الحرب على هذه الشاكلة، بالفعل ما يميز المواجهة الحالية أنها تسقط وهم الحماية المرتبطة بالقبة الحديدية، وتخلق سُبلاً للمواجهة في ظل استراتيجية العدو في خلق طبقات من الفصل والا-احتكاك مع المقاومة على طول الحدود الجنوبية والشمالية وما بينها، أي استحداث جدران إلكترونية وأخرى تحت أرضية تسعى لمنع المقاومة من الاحتكاك المباشر مع قوات العدو. كل هذه الجدران والقبب لم تمنع صرخات الغضب والتلبك على مستوى المجتمع الصهيوني، بل لم تمنع ادخال عصب الاحتلال الديمغرافي إلى قلب المواجهة.
غزة تقاتل لعدة أسباب، ولكنه في لحظة الانتفاض في كافة الأراضي الفلسطينية، لا يمكن لبنية مُعدة من المقاومة أن تقف على بعد مسافة من الحدث. ولا يعني هذا أنها لا تقاتل لأجل حياة كريمة في غزة وأهلها، بل ما تقوم به اليوم يجنبها حملات عسكرية أعتى، ويعيد تذكير العدو بالإمكانيات المتعددة التي تستطيع حفر هوّة أكبر بين المجتمع الصهيوني وما بين قيادته العسكرية والسياسية.
اللد تعيد اكتشاف تاريخها وتنتقم من حاضرها!
اللد تُعيد اكتشاف تاريخ المجزرة، وتنتفض على حاضرها الاجتماعي والاقتصادي المُهمّش، بهذا المعنى تحديداً تقاتل اللد ملتحمة مع باقي فلسطين. ما يحصل في اللد أفضل دليل على الانسلاخ بين الطبقة السياسية في الداخل والتي بدأت بالتحرك لاحتواء توسع الهبة، وبدأت بلعب أدوار الوساطة المعتادة في محاولة احتواء وإيقاف توسع رقعة المواجهة في الداخل الفلسطيني، خاصة بعد استشهاد الشاب موسى حسونة في العاشر من أيار.
اللد مدينة تُعاني من الفقر والإهمال الاقتصادي والاجتماعي، يسكنها أكثر من 30 ألف فلسطيني ممّن هُجّروا إليها من مدن وبلدات أخرى تعرضت لتهجير شامل كالمجدل ومن الأعداد القليلة ممن بقيت عقب احتلالها عام 1948، ويسكنون وسط إحدى أكبر التجمعات الاستيطانية في جغرافيا فلسطين، أي وسط منطقة “غوش دان” وعلى قرب من المطار المركزي لدولة الاحتلال المُسمّى مطارَ “بن غوريون”.
يعيش الفلسطيني بعلاقة تضارب وتوتر دائم مع إحدى أكثر التجمعات الاستيطانية قرباً لليمين الصهيوني، ويعاني أهل اللد من عزل فضائي ومكاني تجلّى في تشييد بعض الجدران التي تفصل بين أحياء المستوطنين والأحياء الفلسطينية، وحاولت المؤسسة الصهيونية تعزيز حالة الفقر والتهميش والتشويه من خلال إسكان العديد من عائلات العملاء الهاربين من قطاع غزة والضفة في الأحياء العربية باللد، وعلى الرغم من وجود هؤلاء إلا أن أهالي اللد يرفضون التعاطي الطبيعي معهم. وبطبيعة الحال، عانت اللد وما زالت من تفشي الجريمة المنظمة ومن الإجرام الداخلي الذي أودى بحياة العديدين من أبنائها، فهي بيئة مادية متهيئة لانتشار الجريمة.
في ظل هذه السياسات الممنهجة من التغييب والتشويه تفاجأت المؤسسة الاستعمارية بانتقال المواجهة للد، بل في تحوّل ملموس على صعيد استخدام السلاح فيها، من حالة توجيه السلاح نحو صدور شبّان اللد وأهلها، إلى حالة توظيف السلاح في اشتباكات مباشرة مع العدو. بالفعل لم يوحّد الموت اللد كما وحدته دماء المواجهة مع الاحتلال، فسيل بشري من الآلاف المشاركين في الجنازة، واشتباكات واسعة مع العدو أدّت إلى هجرة معكوسة تمثلت بخروج بعض المستوطنين وفقدان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على اللد، أي تحريرها في ليلة كشفت فيها اللد عما هو كامن فيها.
هناك العديد من المفارقات لما يحصل في الداخل، بما فيه استجداء الأحزاب المشاركة في الكنيست بالمؤسسة الأمنية لانتشال السلاح من أيدي الناس في الداخل، ومماطلة العدو في الاستجابة لهذا الطلب، وتحول السلاح إلى سلاح مواجهة في وجه العدو وتحول “قطاع الطرق” إلى ثوار في لحظة المواجهة.
مفارقات أخرى كثيرة، بما فيها أن “يغال الون” المخطط لتقسيم ونهش الضفة هو من أشرف على المجزرة في اللد عام 1948، إذ أنها من أكثر البلدات التي تعرضت في أعوام النكبة لقصف جوي ممنهج، وأنها في أسوأ كوابيس الاحتلال لم تتوقع خروج أكثر فئة اجتماعية معزولة اجتماعياً، تعيش في قلب القوة الديمغرافية للاستيطان في فلسطين كلها، لساحات المواجهة، بل وفي ظل سياسات تشويه اقتصادي واجتماعي تم ممارستها على مدى سبعين عاماً.
ما العمل في الضفة؟
بدأ شهر رمضان بعملية نوعية أقدم عليها منتصر الشلبي والذي طوّر مهاراته في القنص وإطلاق النار في الولايات المتحدة، وتضمنت أيضاً محاولة خلية صغيرة مكونة من ثلاثة شبان الدخول إلى فلسطين المحتلة لتنفيذ عملية نوعية داخلها، تخلّلها أيضاً استشهاد الشاب “سعيد عودة” لاعب كرة القدم. في السنوات القليلة الماضية قدمت الضفة أكثر من 400 شهيد، ارتقى غالبيتهم في عمليات نوعية متعاقبة، كانت إحدى مواقعها الأهم البلدة القديمة في القدس وباب العامود تحديداً. لا يمكن لنا فهم سيكولوجية الأحداث في باب العامود دون استحضار تاريخ مهم من استهداف الشرطة “الإسرائيلية” في منطقة باب العامود والبلدة القديمة إجمالاً، فهي خلقت توجساً نفسياً هائلاً عند الشرطة “الإسرائيلية” وجعلت من فرق الإعدام ذاتها أهدافاً، وساهمت في خلق حالة من التوتر الدائم الذي وضع الشرطة في حالة تخبط في محاولتها لمعالجة تلك العمليات.
على صعيد الضفة الغربية، تتمثّل المعاناة في عدة إشكاليات، يمكن اختزالها بالعلاقة مع الفضاء، وبتشكل سلطة الحكم ذاتي في إحدى أعقد منظومات التعاون التي تشهدها جغرافية فلسطين. تمنع هذه السياسات من انتشار هبّة في الضفة، لأنَّ انتشارها يعني اقتتالاً داخلياً ستوظّف فيه السلطة عضلاتها، من خلال تجييش تنظيم فتح وامتداده الاجتماعي بما فيه كوادر الأجهزة الأمنية لقمع أي توجّه رامٍ إلى الضغط والتخلص من منطق التعاون مع الاحتلال والطبقة السياسية والاقتصادية التي اختارت التعاون كسياسة ممنهجة. لهذا، فإنّ أية مواجهة في الضفة عليها أن تسعى لخلق حالة اصطدام تحاول فيه تحييد تنظيم فتح، بل مطالبة التنظيم بمعناه القاعدي من الانتفاض على بنية التعاون ذاتها، فالمواجهة مع رأس الهرم وليس مع كافة الشرائح المشكلة للسلطة الفلسطينية. بالفعل، لقد أخذت النخبة الحالية فتح رهينةً لسياستها التي لا تعبر فقط عن انسلاخ كامل عن الحاجة للمواجهة حتى لو كانت محدودة، بل تتعدى ذلك إلى خلق حالة انتحار سياسي لحركة وطنية ما زال في طياتها طاقات تشعر بشعورنا جميعاً، وتفرح بكل صلية صواريخ تطال تل أبيب.
بهذا المعنى فإنّ على المواجهة في الضفة، أن تكون مواجهة لاستئصال النخبة، وليس لإسقاط فتح، وهنا ينتقل الثقل على التنظيم، فما الذي تريده فتح، هل تريد مواجهة مع المجتمع، أم الالتحام معه لحظة المواجهة. إذا اختارت المواجهة مع المجتمع فهذا خيارها، وقد تستطيع احتواء التظاهرات ولكنها تضعف وتحاصر نفسها وتؤسس للانكشاف والتعرّي السياسي أمام قاعدتها وأمام المجتمع برمته. أما على صعيد آخر، فإن إعادة وضع العقوبات على قطاع غزة في ظل التحام جماهيري عارم على مستوى جغرافية فلسطين يعدّ جريمة سياسية ووطنية كُبرى. فإذا ما أرادت الأحزاب المعارِضة تشكيل هذه الحالة، فعليها أولاً وقبل كل شيء أن تعي تماماً أنه دون المواجهة السياسية مع تيار التعاون في الضفة سنبقى نترنح بالوضع القائم، وأنّ إسقاط أوسلو لن يأتي بقرار ممّن وقع واغتنى من أوسلو بل سيأتي ممن أغرق بالديون، ومن وضع في سجون السلطة، ومن يتم الاحتيال عليه في بنية السلطة نفسها، أي من العناصر الصغيرة في الأمن وكوادر فتح.
إنّ إسقاط الجدار الأمني الأول للاحتلال، أي السلطة كمنظومة تعاون في الضفة وتحويل المسار السياسي في الضفة سيغير من شكل الهبة، ويضعنا أمام مهمة بناء نموذج جديد مبنيّ على الصمود المقاوم، وعلى إعادة بناء مجتمع جديد لا يتخلله استقطاب طبقي حاد، ويسعى لتثبيت علاقة رادعة مع الاحتلال نستطيع فيه اجتراح عدة مكتسبات معنوية وسياسية، وحتى اقتصادية. ويتطلب هذا ائتلافاً واسعاً من الأحزاب والتيارات السياسية المقتنعة بضرورة المقاومة، فالحّد الفاصل في المجتمع الفلسطيني اليوم بين قوى المقاومة، وقوى التي امتهنت التعاون والاستقواء بالعدو.
بهذا المعنى تتخذ شكل الهبة في الضفة عدة مفاصل بحسب الموقع الجغرافي وظروفه. ما أظهرته القدس من أنّها تستطيع إعادة إنتاج معادلات جديدة بالعلاقة مع الاستعمار، بما فيها ضرورة تكثيف المنجزات على مستويات صغرى، وهنا تحديداً تختلف مثلاً حالة مدينة الخليل التي تواجه الاستعمار في بلدتها القديمة كما تواجه محاولات الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي، وما بين رام الله التي تشكل مركزاً اجتماعياً للسلطة ونخبتها، وما بين الريف ونقاط الاحتكاك المتنوعة في الضفة. بتعبير آخر، يمكن بناء استراتيجية عامة، ولكنها بنفس الوقت تتخذ بعين الاعتبار حساسية التكتيكية لكل موقع جغرافي، ولما مطلوب إنجازه في كل موقع.
كيّ وعي العدو
هذه الهبة هبة كيّ وعي مُعاكس، هبة ترمي إلى النقش والحفر في الوعي الجمعي لهذا الاحتلال ومن يقف جانبه من قوى سياسية، ذلك أن الطاقة الكامنة لدى المجتمع الفلسطيني، وبل قدرته في ظل أحلك الظروف وأكثرها صعوبة على إعادة تعريف أفق الممكن قائمة، بل تتوسع عبره في العقد الأخير.
لم نعد نخوض الانتفاضات والهبات بشعارات كبرى كالتحرير والسيادة أو إقامة الدولة، وما نخوضه اليوم معارك كيّ وعي للعدو ترمي إلى خلق معادلات ردع جديدة، في ظل شعور يمرّ عبر الجهاز العصبي لكل فرد فينا، شعورٌ أننا أقوى، وأن من أمامنا أضعف مما يُظهر ويدعي. نخوض معارك مُصغرة تنبع من استمرار الصراع في كافة جغرافيا فلسطين، معركة بقاء ووجود وصمود، أحيانا ما تتخذ شكلاً مصغراً، إلا أنها تستطيع أن تتحول إلى هبة عارمة أو حتى انتفاضة، في مفارقة عجيبة، تحررنا من الشعارات والادعاءات الكُبرى أتاح لنا أن نشعر بامكانية الوصول إليها، ليس من خلال القول، بل من خلال ممارسة الاشتباك.
هذه الهبات إعادة اكتشاف للقدرة الجماعية على خلق واجتراح أفق جديد لما هو ممكن، ولأن الطبقات السياسية التقليدية خارج المواجهة وتقف بعداء معها، لا تؤثر على الأحداث. ما نحققه بأجسادنا الممتدة وعضلاتنا القابضة على السلاح والحجر والمولوتوف، وعلى السيل البشري الممتد على طول فلسطين إعادة اكتشاف القوة الكامنة فينا، كوحدة واحدة، ومصير واحد، ومجتمع وشعب حيّ يقاتل بتعدديته وبطرقه كل حسب موقعه وخصوصيته، فإذا ما كان هناك من خصوصية فهي ليست خصوصية الاستثناء، بل خصوصية الأدوات وخصوصية الحركة التي تولد لحظة الانقضاض. في ظل هذا الظرف علينا أولاً وقبل كل شيء التخلص من بنى التعاون، تلك التي تطلق بيانات التهدئة، وتقمع قدرتنا على الالتحام مع الهبة المباركة في الضفة.
هذه انتفاضة على نموذج يعتقد أن نجاته ترتبط بالعلاقة والاستقواء بالعدو إما داخل قُبب الكنيست المزينة بدمائنا، أو تلك التي مأسست الهزيمة وتحاول تحويلها إلى مقولة أبدية. هذه انتفاضة على رفع الجريمة التي تتفشى داخل المجتمع الفلسطيني، وانتفاضة تُعيد تعريف بوصلة السلاح. انتفاضة على من ربط مصيره مع العدو، بالعالم العربي، وبفلسطين نفسها، انتفاضة على من يستقوي بالعدو في كل الجغرافيا العربية.
وقد يكون أكثر ما يشير إلى حالة الاضطراب التي ولدتها الهبة خروج قطعان من المستوطنين في كافة المدن والبلدات المختلطة في الداخل، ومحاولة تلك القطعان إعادة التوازن لنفسها في ظل شعور عارم أصابها أن دولة الاحتلال والمؤسسة الأمنية التابعة لها فقدت قدرتها على التعامل مع الهبة الشعبية واحتواءها. هذا السعي نحو إعادة التوازن، إما على مستوى الجيش واستخدامه المكثف للقصف، أو على مستوى انفلات بعض المستوطنين في الداخل الفلسطيني المحتل، ومحاولة استعادة التوازن النفسي من خلال رفع السلاح الذي يملكه المستوطن في وجه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده.
ونذكر هنا أن المشهد الانتفاض يُعيدنا إلى هبة البراق عام 1929 والتي تخللها مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمجتمع الصهيوني الناشئ في فلسطين، في زمن كنا فيه أقوى، وكان المجتمع الصهيوني أضعف، لا يملك ترسانة السلاح والجيش الذي يملكه اليوم، وبالرغم من ذلك يتكرر المشهد والحدث وتكرر صورة المواجهة على طول وعرض فلسطين، وكأن دورة الزمن لعبت دورها الفاعل في إعادة التوازن لنا، وفي خلق وتكثيف حالة الإرباك عند العدو.
ما نعيشه اليوم لحظة مفصلية، ليس فقط لما تكشفه من ضعف على مستوى المجتمع الصهيوني، وقدرته على القتال، بل قدرته على إنتاج القادة، أو حتى على مستوى تآكل المؤسسات الأهم لديه، بما فيه مستوى القيادة السياسية والعسكرية، بل أيضا لما نستطيع حفره ونقشه وتعزيزه في وعي العدو، وإعادة تذكيره أن سؤال بقائه على الأرض ما زال هو السؤال!