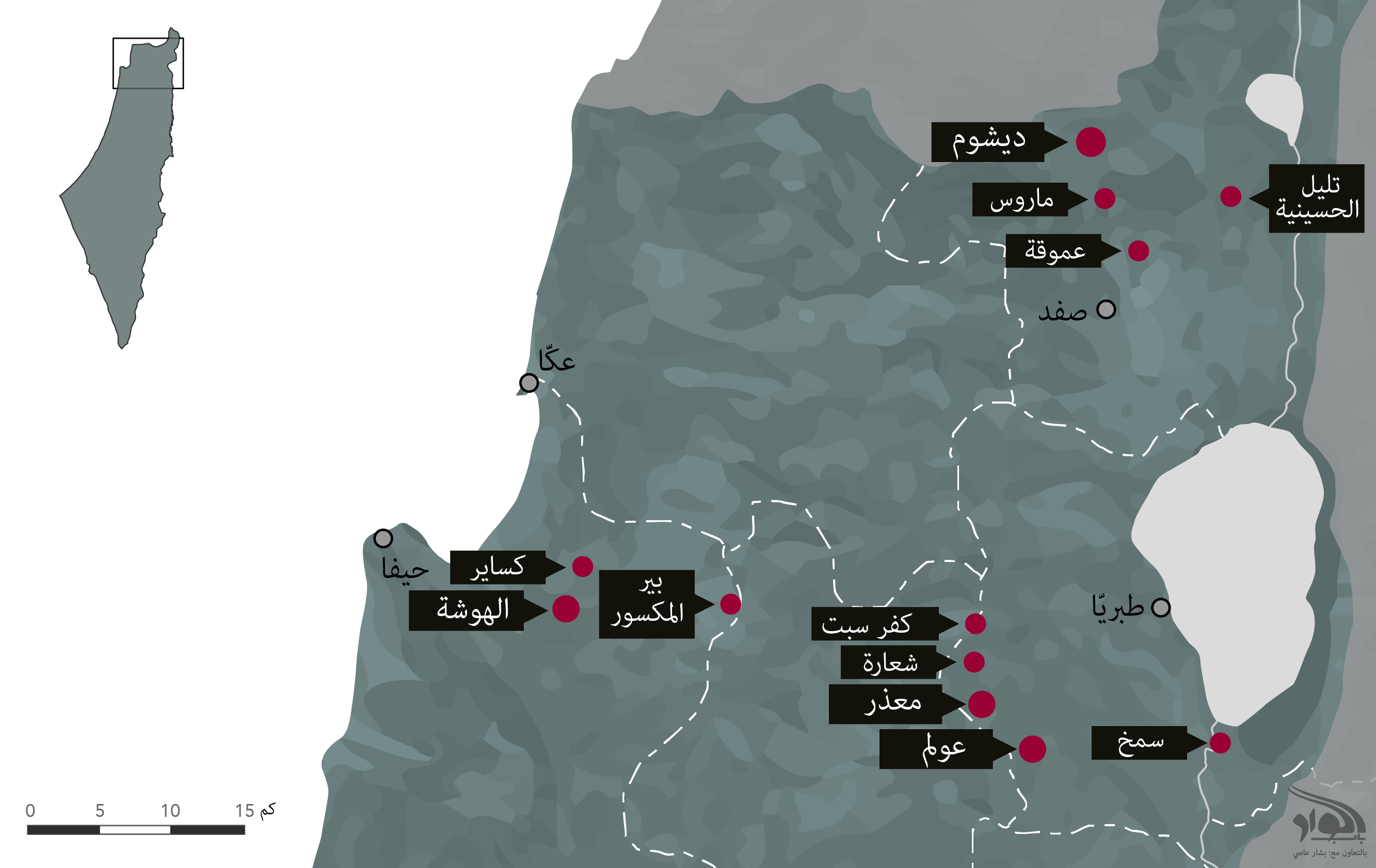سيتبع هذا النص خطاً ثلاثياً، إذ يراجع في أولى محطاته كيفية تناول زياد قاسم للقضية الأرثوذكسية في روايته في منحاها الدرامي، عبر شخوص الرواية المعنية بهذا، ومواقفها، وسيروراتها، ثم سيربط هذه المراجعة بالسياق التاريخي لمعركة النضال في سبيل تعريب الكنيسة واستردادها من السيطرة اليونانية، عبر مسار مختصر لتاريخ السيطرة وجذورها وخلفياتها السياسية، وصولاً إلى التطرق لأحد أهم شخصيات النهضة الأرثوذكسية العربية عبر مراجعة مواقف وأفكار خليل السكاكيني.
مقدمة
على مدار السنوات الأخيرة، تصاعدت بحدة أزمة الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين، ولعل الأصح أن نسمّيها أزمة العلاقة بين الجماعة الوطنية الفلسطينية في الطائفة، والقيادة الروحية اليونانية. جاء احتدام الأزمة، كما هو معروف، على خلفية فضائح تسريب أملاك الوقف الأرثوذكسي، من خلال البطريرك ومساعديه إلى شركات ورجال أعمال صهاينة، بل إلى مؤسسات صهيونية رسمية وجمعيات ومنظمات يمينية متطرفة.
ومما لاشك فيه أن سيطرة القيادة الروحية اليونانية الممثلة تنظيمياً بما يعرف بـ”أخوية القبر المقدس”[1] على كل مناحي الحياة في الطائفة، وخصوصاً في السياقين السياسي والاقتصادي، يجعل دورها يتجاوز مجرد كونها قيادة روحية، ويُضفي على الأزمة طابعاً أكثر عمقاً وجذرية من مجرد تسريب الأملاك على خطورته، وصولاً إلى واقع هذه الكنيسة، وما يعنيه وجود طبقة أجنبية متحكمة في مقادير الكنيسة وقدراتها، مقابل عزل الوطنيين من أبناء الرعية عن أي دور أو مركز قرار.
ما سبق يحيلنا إلى العمق التاريخي للأزمة، التي لا يمكن القول إنها وليدة اليوم، أو السنوات الأخيرة، فتاريخ نضال الطائفة الأرثوذكسية العربية في فلسطين، في سبيل تصحيح مسار كنيستهم واستردادها من أيدي الكهنة اليونانيين، تاريخ طويل وعريق؛ ويعود بالتأكيد إلى زمن تثبيت نفوذ رهبان وعائلات الفنار اليوناني الإسطنبولي، وتثبيت نفوذهم في مفاصل الحكم العثماني، ما أدى إلى عزل أو إقالة آخر بطريرك عربي في القسطنطينية[2]، ودخول الكنيسة مسار “اليوننة” منذ ذلك الحين.
حازت القضية الأرثوذكسية على تغطية كبيرة، في سياق الكتابة التاريخية عن فلسطين، لأسباب تتعلق بحجم التداخل الدولي العثماني -اليوناني- الروسي، والصراع المحتدم للسيطرة على الكنيسة، أو بسبب نشأة تنظيمات فلسطينية أرثوذكسية وطنية وجمعيات مناهضة لسيطرة الكنيسة اليونانية، وارتباطها بشخصيات فلسطينية كبيرة من وزن خليل السكاكيني على سبيل المثال. وقد تعرّض الأستاذ السكاكيني للقضية الأرثوذكسية في مساحة واسعة من يومياته، كما كتب فصلاً كاملاً بعنوان “النهضة الأرثوذكسية”[3] يتحدث فيه عن مشروع تصحيح الكنيسة الذي كان مبادراً إليه وانتهى بانشقاقه.
أما في الأدب، فلم يعثر الكاتب على أي عمل أدبي يتناول القضية الأرثوذكسية، في سياق تاريخي، سوى رواية “الزوبعة”[4] للروائي الأردني زياد قاسم[5]. تتناول الرواية القضية الأرثوذكسية في سياق الخلفية التاريخية التي أحاطت بتطورات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتتطرق بوضوح إلى طبيعة العلاقات بين العنصرين العربي واليوناني في إطار الكنيسة بروحٍ نقديةٍ كشفت عسف وجور اليونانيين المسيطرين.
سيتبع هذا النص خطاً ثلاثياً، إذ يراجع في أولى محطاته كيفية تناول زياد قاسم للقضية الأرثوذكسية في روايته في منحاها الدرامي، عبر شخوص الرواية المعنية بهذا، ومواقفها، وسيروراتها، ثم سيربط هذه المراجعة بالسياق التاريخي لمعركة النضال في سبيل تعريب الكنيسة واستردادها من السيطرة اليونانية، عبر مسار مختصر لتاريخ السيطرة وجذورها وخلفياتها السياسية، وصولاً إلى التطرق لأحد أهم شخصيات النهضة الأرثوذكسية العربية عبر مراجعة مواقف وأفكار خليل السكاكيني.
زياد قاسم والزوبعة
 تعدّ رواية الزوبعة بطابعها الملحمي وحجمها الضخم أبرز روايات زياد قاسم على الإطلاق ولعلها مشروعه الأساسي، حيث تتبع عبرها تاريخ المنطقة في بلاد الشام والعراق ومصر والجزيرة العربية منذ ستينيات القرن التاسع عشر، بأسلوب درامي، عرض فيه التاريخ السياسي والاجتماعي والتطور الاقتصادي الحضري، عبر شخصياته التي يمكن إرجاع الكثير منها إلى أصلها الواقعي. كما برزت شخصيات حقيقية تاريخية كلاعبين أساسيين في الرواية التي تنتهي فصول أجزائها الستة مع نكبة فلسطين.
تعدّ رواية الزوبعة بطابعها الملحمي وحجمها الضخم أبرز روايات زياد قاسم على الإطلاق ولعلها مشروعه الأساسي، حيث تتبع عبرها تاريخ المنطقة في بلاد الشام والعراق ومصر والجزيرة العربية منذ ستينيات القرن التاسع عشر، بأسلوب درامي، عرض فيه التاريخ السياسي والاجتماعي والتطور الاقتصادي الحضري، عبر شخصياته التي يمكن إرجاع الكثير منها إلى أصلها الواقعي. كما برزت شخصيات حقيقية تاريخية كلاعبين أساسيين في الرواية التي تنتهي فصول أجزائها الستة مع نكبة فلسطين.
من الممكن تلخيص خط الرواية الدرامي بكلمات الكاتب نزيه أبو نضال: “إن الأحداث الروائية في الزوبعة ورغم امتدادها الواسع جغرافياً، إلا أن خطها المحوري يسير على خط الحديد الحجازي. فبموازاة هذا الخط، يتحرك مسار التاريخ المعاصر للمنطقة العربية بخطوطه الكبرى، وبوقائعها الجزئية والتفصيلية، حيث أقام زياد قاسم عالمه الروائي، ولعبت دور البطولة فيه مئات الشخصيات والأحداث التي تتداخل فيها الوقائع الحقيقية بالأحداث والشخصيات الواقعية، وإن لم تكن حقيقية”[6].
حمل عنوان الرواية “الزوبعة”، كما يشير عدد من النقاد، معنىً مركباً، فهي من جهة الزوبعة الحقيقية التي تثير بدوامتها الكثير من الغبار، في انعكاس للبيئة الصحراوية التي تدور فيها أحداث أجزاء كثيرة من الرواية. ومن جهة أخرى، تنطوي الرواية على تمثيل رمزي للثورة العربية الكبرى، والتي رغم ما خلفته من أضرار أدت في سياقها التاريخي إلى تطبيق معاهدة سايكس-بيكو وتجزئة المشرق العربي والاستعمار الغربي، إلا أن خيرها ربما وبتدقيق مكثف، تمثل في خروج هذا الشرق من ربقة الحكم التركي الفاسد والمظلم، وتحريك المستنقع السياسي والاقتصادي الآسن الذي خلفه هذا الحكم في عقوده الأخيرة.
كما ينعكس البعد الأيديولوجي للروائي في اتباعه، دون إعلان، فكرَ الحزب القومي الاجتماعي السوري ومؤسسه أنطون سعادة الذي كان له ولأتباعه نصيب وافر في الرواية، وينعكس أيضاً في الاتجاه الروائي العام والنظرة إلى بلاد الشام وسوريا الطبيعية كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، مع ربط هذا بتوجه قومي أكثر شمولاً تجاه وحدة العرب وضرورة حيازتهم استقلالهم السياسي. يقول قاسم في شهادته عن نفسه كروائي: “في كتاباتي تمثّلت الماضي الذي صنعني، والمستقبل الذي أحلم بصناعته في صور مكانية زمانية عبرت عن البيئة السورية وظروفها الاجتماعية في تراكمات حضارية تضمنت الجغرافيا دون أن تكونها واشتملت على التاريخ دون أن تتقمصه”[7].
لم يتوقف قاسم عند الأبعاد السياسية لتاريخ الاحتلالات، وخصوصاً العهد التركي والثورة العربية الكبرى، ثم اغتصاب فلسطين ومآلات الأبطال ارتباطاً بهذه “الزوبعة” الجيوسياسية، بل ذهب إلى عمق النسيج الاجتماعي –الديني، وهو وإن بدأ ملحمته بالمذابح الطائفية[8] التي عايشتها بلاد الشام في ستينيات القرن التاسع عشر، فقد أبرز بشكل كبير- وبعيداً عن هذا التعصب الطارئ- التسامح القوي بين الأعراب المسلمين والمسيحيين في القرن التاسع عشر، من الجزيرة العربية وحتى امتداد ساحل البحر الأحمر، وصولاً إلى الكويت مروراً بالعراق، ونزولاً الى سواحل الخليج .. منتصراً دائماً لفكرة الجماعة العربية ووحدتها الجغرافية واللغوية والسياسية.
نجد في الرواية الأتراك والصرب واليونانيين والعرب من سوريا والعراق وفلسطين ولبنان وشرقي الأردن والجزيرة العربية، كما نجد الشركسي واليهودي الأفاق، والحضري والقروي والبدوي، والمعلم والراعي، والعسكري المستعمر والثائر، والخائن والشهيد، وغيرها من العناصر التي شكلت تلك اللوحة. إضافة إلى ذلك، أرى أن تلك الرواية هي من أولى الأعمال التي عالجت تدفق الهجرات الداخلية الجماعية والفردية في أقطار بلاد الشام وبينها، وأثرها الجذري في التأسيس لعلاقات ومصائر جديدة للمجتمعات، بل في تشكيل مجتمعات جديدة وإحداث تغييرات جوهرية في النسيج الاجتماعي والتشكل السياسي والاقتصادي.
تعدّ هذه الرواية على الأغلب الرواية الأولى، إن لم تكن الوحيدة، التي رصدت ليس فقط تطور مجتمعات، بل إقامة مجتمعات سياسية جديدة، متتبعاً أدق التفاصيل التي لن يجد الباحث أي عناء في توثيقها تبعاً لأفضل المؤلفات التاريخية والمصادر التي لاشك فيها. وعلى أهمية هذه الرواية التي أرى أنها لم تأخذ حظاً أو نصيباً عادلاً من المراجعات النقدية- في حدود معرفة كاتب هذا النص- وعلى أهمية البحث فيها ومناقشتها وتتبع بناءَها الفني والوظيفي، إلا أن موضوعنا هنا ينصب على جانب واحد مما تناولته، ولعلها الوحيدة التي تطرقت إليه؛ أعني المسألة الأرثوذكسية وتاريخية الأزمة في الكنيسة الأرثوذكسية.
رصد زياد قاسم عبر شخصيات أرثوذكسية من أبطال الرواية العلاقات التراتبية داخل الكنيسة الأرثوذكسية التي أعيد هندستها منذ القرن السادس عشر على تفوق وأولوية العرق اليوناني، ومنع الارتقاء العربي، وعرقلة اندراج العرب في سلك الكهنوت، والنظرة التي حملها الكهنة اليونانيون للعنصر العربي الذي عاشوا في دياره. وسنرى لاحقاً في هذا النص أن ظروف الهيمنة والاستبعاد لم تكن أمراً طارئاً، بل كان مرتبطاً بخطة محكمة وضعها تنظيم “أخوية القبر المقدس” ومؤسسوه، انطلاقاً من الشعور والإيمان بتفوق اليونانية وسيطرتها.
القضية الأرثوذكسية كما ظهرت في رواية الزوبعة
في إطار الخلفية السياسية الاجتماعية للأحداث الجارية في أواخر القرن التاسع عشر، يقدم زياد قاسم ثلاث شخصيات “أرثوذكسية” يشرح من خلالها واقع العلاقات السائدة في ذلك الوقت بين العنصرين اليوناني والعربي في الكنيسة والإكليروس[9]، وهي رجا الصليبي العربي من قرية المجيدل[10] قرب الناصرة، وإيليا أو الأب سمعان لاحقاً من ظهور الشوير في لبنان، وأسقف السلط القادم من مكان ما في اليونان.
تبدأ الرواية منذ صفحتها الأولى بإعلان غامض عن رجا الصليبي، أول الشخصيات المركزية الذي حول أرضاً تسمى القبة في صحراء شرقي الأردن، يملكها بدو قبيلة الجبيلية، إلى أكبر قرية زراعية على حافة الصحراء؛ رجا “النصراني” الذي صار اسمه بتتويج من الشيخ زعل شيخ الجبيلية شخصياً: الشيخ رجا، ولكن “أيعي شيخهم ما يقول؟ القبة لرجا الصليبي؟ وعمله شيخ كمان!” (الزوبعة- ص3). ومن سيكتب عقد تنازل الشيخ زعل عن القبة للشيخ “المستحدث” رجا؟ “باكر تجيب خوريكم ودي إياه يكتب هالشي وأنا أبصم عليه” (الزوبعة- ص4).
بهذه الواقعة المركزية يحدد زياد قاسم مسار الحكاية كلها، ويوطد لطبيعة العلاقة التاريخية التي جعلت مسيحياً من قرية قرب الناصرة يتحول إلى شيخ بدوي على سيف صحراء شرقي الأردن. لم يكن رجا يشعر نفسه غريباً وإن كان نصرانياً على غير دين هؤلاء “الأعراب”، ويقول لهم “أنتم ربعي يا شيخ” (الزوبعة – ص4)؛ يقولها بثقة المستغني عن كل شيء.
رجا
أطلق بدو الجبيلية لقب الصليبي على رجا. وعندما وقعت المجزرة في بلدته المجيدل في ريف الناصرة من أعمال ولاية سوريا في ذلك الوقت، وأكلت الأخضر واليابس وأرواح الناس، فر رجا هائماً على وجهه أياماً وليالي، لتلتقطه الصحراء بعد عبور النهر. وقعت تلك المجزرة يوم أحد، أثناء القداس الذي لم يذهب إليه رجا متعللاً لوالديه بحاجته لاستنشاق هواء الحقول.
وعندما عاد ورأى الجثث والأكواخ المحترقة والرؤوس المقطوعة المتفحمة، هام على وجهه، ثم رأى أعمدة الدخان تحوم فوق الناصرة. هذه المرة قتل المسيحيون المسلمين، وهو لم يكن يريد إلا أن يهرب (الزوبعة ص-13،14). وفي حوار مؤثر يدرجه قاسم، يلتقي رجا بكاهن مسيحي على رماد الناصرة..
“-ليش يا أبونا.. ليش؟
-العين بالعين يا ابني
-ليش بقي في الدنيا عيون .. آخ.. آخ” (الزوبعة-ص21)
وهام على وجهه حتى وصل إلى السلط، ودخل على سمعان وصار في صحبته حتى أدخله في خدمة الشيخ عواد.
سمعان
في ظهور الشوير من أعمال جبل لبنان، حدثت قصة أخرى؛ كان إيليا ووالده الفراء في طريقهما إلى بيروت لبيع بعض فروات الخراف، وشراء ما تحتاجه العائلة من مؤن واحتياجات، عندما اصطدما باثنين من الجنود الأتراك، يجوبان المنطقة بحثاً عن غنيمة، فوقع بين أيديهما إيليا ووالده، طمعاً بفروة ثم تطور الأمر إلى مذبحة.
“كافر” هذا ما وصف به الجندي التركي والد إيليا قبل أن يلهب ظهره بنيران سوطه، وظهر إيليا أمام الباب يحمل بارودة أبيه، يدكها بملح البارود، وهو يتقدم إلى الأمام “والله لأقوسكم”. وقبل أن يتمكن العسكري من امتشاق بارودته، ضغط إيليا الزناد، فارتد جسد العسكري إلى الوراء وهو يجأر. ثم قتل العسكري الآخر بعد أن انتزع منه سيفه، قتله به، وصار الباقي جزءاً من التاريخ: مذبحة مروعة في ظهور الشوير، كما رجا، هام إيليا على وجهه لامساً الصليب مصلياً للمسيح.(الزوبعة ص31-43)
وبينما كان إيليا ينبش عن بقايا طعام في كومة زبالة، وجد ورقةً من جريدة حملت إليه أخبار الفجيعة: “تم إعدام المجرم واصف كنعان، الذي قتل وابنه جنديين في محاولة لسرقة حصانيهما، البحث جارٍ عن المجرم إيليا واصف كنعان”. رواية المنتصر للحدث قصةٌ كاذبةٌ أخفت عسف الجنود وجورهم، ولكنها الحكومة “حتى في القمامة توجد الحكومة” (الزوبعة ص49). وصل إيليا إلى دمشق ضائعاً خائفاً جائعاً، وعندما أحسن إليه أحدهم في الطريق وسأله عن اسمه، أعطاه اسماً زائفاً: سمعان.
وبدون أن يدقق الرجل في عقيدة سمعان، جنّده لحراسة قافلة الحج، ولم يأبه عندما قال له سمعان إنه مسلم شيعي، فالرجل كان يريد رجالاً لحراسة القافلة بأي ثمن. وبعدها، أنقذه الشيخ عواد، والد زعل وشيخ الجبيلية قبله من براثن اللصوص، وهو يرسم الصليب على صدره مرتعباً من الموت النازل عليه بسيوف أولئك الهمج وبنادقهم: “إنت نصراني؟ قوم قوم.. نصراني ولا غيره إنت بجيرة الشيخ عواد” (الزوبعة ص63). لم يستطع الجبيلية أن يستوعبوا الكلمة، إذ يريد سمعان الذهاب إلى كنيسة أرثوذكسية. قال عواد : أنا أعرف كنيسة وبس، نوديك ماشفتها زينة نوديك غيرها لتلاقي كنيسة على كيفك”(الزوبعة-ص69).
الصدام
عبر العلاقة بين سمعان والكاهن جابر والأسقف اليوناني، يكشف زياد قاسم طبيعة العلاقة التي تحكم طرفي التناقض في الكنيسة الأرثوذكسية؛ تناقض فرضه العنصر اليوناني الغالب على العنصر العربي المغلوب. وبدلاً من أن تكون الكنيسة موطناً روحياً لجميع رعاياها، تحولت إلى استئثار خاص، وكنز يريد الكهنة اليونانيون أن يحوزوه، حتى لو كانت أعطيات الكنيسة وأملاكها في ديار هؤلاء العرب ومن عرقهم، حيث تتحدد الطبيعة العرقية لنظرة هؤلاء، كعرب لا يستحقون الكنيسة وليسوا جديرين بعظمتها. وكأن هؤلاء اليونانيين الذين اغتصبوا الكنيسة و الإكليروس، وصاغوه على مصلحة عنصرهم، نسوا أو تناسوا أن يسوع المسيح كان عربياً.
وسنرى في الجزء التالي من هذا النص كيف احتل اليونانيون الكنيسة في إطار استغلال طبيعة الحكم التركي وفساده، وكيف استخدم الأتراك وسلطتهم اليونانيين كعنصر إخضاع للرعية الأرثوذكسية العربية التي كانت تفتخر بعروبة كنيستها وبطركها قبل وقوع المشرق العربي في قبضة العثمانيين، تماماً كما استخدمت أقليات أخرى لإخضاع فئات أخرى من المجتمع العربي، كاستخدامها الألبان والشركس وغيرهم من فئات.
تقول الرواية: “الذوبان الروحي هو الذي جعل الأب سمعان يحتمل لسنوات جور وطغيان أسقف السلط لأرثوذكسي، كان طلبه تكريس نفسه للكنيسة بحد ذاته مبعثاً للشك والريبة”، وبمجرد أنه عربي قال له الأسقف: “أنت خرامي ولا شحاذ؟” (الزوبعة-ص386). هل يعقل أن يكون عربي مسيحياً؟ فما بالك أن يكون أرثوذكسياً أيضاً، وقد صارت الكنيسة الأرثوذكسية منذ القرن السادس عشر الجنة الخاصة لليونانيين الذين طرؤوا على البلاد كفيضان في رعاية السلطان الجالس على كرسي الحكم في اسطنبول.
“مسيخ.. مسيخ كل أرابي مش قادر ياكل يصير يقول مسيخ” هكذا يصرخ الأسقف الأرثوذكسي في وجه جياع رعيته العرب (الزوبعة- ص387)، وكأن المسيح جاء للكروش المنتفخة وليس للفقراء والشحاذين والجائعين، “أراب ما بعرف مسيخ إلا لما يجوع، إخنا ما عنا أكل”(الزوبعة- ص387).
لكن إذا لم يكن سمعان العربي مقبولاً في السلك الكهنوتي، فيمكن استغلاله كخادم برغيف خبز. وهكذا استخدمه الأسقف برغيف خبز واحد يدفع له في نهاية اليوم في أسوأ الأعمال وأحطه وأشقاها، بينما يتنعم الكهنة اليونانيون بخيرات البلاد ونعم الكنيسة وعطايا المؤمنين، وسيرى القارئ الكريم كيف أن هذا السلوك طبيعي تماماً، بل ومنصوص عليه في دستور “أخوية القبر المقدس” الذي سنعرضه في قسم لاحق.
إن تواضع سمعان وقبوله بهذا الوضع لم يشفعا له عند الأسقف المسلح بنظرة عنصرية لا يمكن تفكيكها تجاه العنصر العربي، فالعرب برأيه “لم يكونوا يوماً ولن يكونوا رعية وفية للمسيح” (الزوبعة –ص 388)، إذ كان يعتبرهم عالة على الطائفة وطقوسها الراقية التي هي من حق أبناء اليونان وحدهم، فالعرق اليوناني من وجهة نظره هو حامي الكنيسة وعقيدتها من أي إفساد قد تجلبه العناصر الأخرى. وكان الأسقف قد قرر سلفاً رفض رغبة إيليا بالانضمام لسلك الرهبنة، ولكنه بالمقابل سيستثمر هذا الشاب ويستنزفه في أصعب الخدمات وأضناها، مقابل رغيف الخبز اليابس “الذي يدفع له كما تدفع الصدقة”(الزوبعة-ص388).
يروي زياد قاسم قصة أخرى، تعكس الموقف العرقي- الطبقي من قبل الكنيسة الأرثوذكسية تجاه رعاياها العرب: في إحدى المرات وجد سمعان طفلاً شريداً في الحقل يعاني من البرد والجوع والخوف، فأحضره معه إلى الدير وسرعان ما وصل الخبر إلى الأسقف، “فجاءه هائجاً مائجاً غاضباً يتبعه رتل من الرهبان” “ولك شو بتعمل يا خمار؟- يا سيدي الصبي ضايع وراح يموت من الجوع- يموت إنت كمان.. هادا كنيسة مش ملجأ”.
-يا سيدي أنا بتقاسم معه خبزتي – ليش إنت إلك خبز يا خمار؟ يالا روخ من هون إنت وهو”، و”ولك أرب كله جوعان.. من وين بدي أطعمي أنا” (الزوبعة-ص391).
وعي سمعان للعالم في ذلك الوقت لم يساعده على تفسير موقف الأسقف، لا يعرف إيليا أشياء كأخوية القبر المقدس، أو انقسام العالم إلى عناصر متراتبة، كالاستعمار والعنصرية التي عرفها خلفه الواقعي خليل السكاكيني، وأن يكون هناك تفاوت وأفضلية لعرق ما على عرق آخر، تتيح له استغلاله والتسلط عليه. لم يكن إيليا أو سمعان يعرف سوى أن أبناء الرب متساوون، ينظر إليهم بذات العين، ولكن الكاهن جابر يشرح له.
تقدّم الرواية الكاهن جابر كواحد من العرب القلائل الذين قبلوا في السلك الكهنوتي الأرثوذكسي، ولكن دون أن يتاح له الترقي في السلك أو التقدم في تراتب الهرم الكنسي. تشرح الرواية على لسان الكاهن جابر ما استعصى على وعي إيليا: “عارف يا إبني ليش الأسقف قاعد يآجر فيك؟ لأنك بس عربي، ولو كنت يوناني متله كان زمان صرت راهب، ويمكن أنا صرت مطران، ومتلنا متايل في كل مكان فيه كنيسة أرثوذكسية” (الزوبعة –ص399-400).
كشف جابر لإيليا كل شيء عن حقيقة الكنيسة الأرثوذكسية؛ أمور لا يجرؤ الكاهن نفسه على البوح بها، لكنه وجد ملجأه في عربي مضطهد مثله. كلاهما عربيان مسيحيان، وكلاهما أرثوذكسي، ومضطهد لأنهما عربيان. فـبينما يخدم الكاثوليك والبروتستانت رعاياهم، أياً كانت أصولهم أو جذورهم، فإن البطاركة الأرثوذكس يعتبرون الكنيسة امتيازاً لهم وحدهم، فلا مدارس ولا مراكز صحية ولا اهتمام بشؤون الرعية رغم أنها الكنيسة الأكثر ثراء في المنطقة. ويعود ذلك حسب الكاهن جابر إلى احتقار البطاركة اليونانيين للعنصر العربي، و”عدم السماح لهم بالترهبن في أخوية القبر المقدس، ومنعهم من انتخاب الأساقفة والمحاكم الكنسية، فيما البطاركة اليونانيون منغمسون في ملذاتهم وشهواتهم” (الزوبعة-ص400).
ستعود قصة سمعان مع الصبي المشرد لتتكرر في القدس، ولكن مع صبي آخر، لا شك في أرثوذكسيته، ولكنه عربي، حيث يعمل سمعان معلماً في المدرسة الأرثوذكسية، ضمن ظروف لم تفصح عنها الرواية. وثمة تلميذ يدعى بشارة، فقير معدم، يطلب سمعان من المطران اليوناني إيواءه بالدير، وسمعان قد صار كاهناً معروفاً ومعلماً شهيراً، وليس ذلك المشرد الذي عرفناه أول التحاقه بكنيسة السلط، بل إن بشارة نفسه قدم لمدرسة الكنيسة خدمات جليلة. لكن موقف المطران اليوناني في القدس لايمكن أن يكون مختلفاً عن موقف أسقف السلط “لو عرف الناس أن الكنيسة تأوي المشردين، لجاء إلينا منذ الغد عرب القدس كافة ولربما كل عرب فلسطين” (الزوبعة-ص 659).
وهكذا يعيد التاريخ نفسه “إنها القصة القديمة، لو كان بشارة يونانياً، لما تردد المطران في إيوائه، ليس الأتراك وحدهم متعالين على العرب..كل الشعوب تتعالى عليهم” (الزوبعة-ص660).
الانشقاق
لا تترك الرواية الأمر معلقاً بدون حل، وكان التمرد الأول ولعله الثورة الأولى إقناع الكاهن جابر لإيليا (سمعان) بالانضمام إليه في انشقاقه عن الأرثوذكسية والتحول إلى الأنجيليكانية، فـ”المسيح نفسه المسيح عند الجميع، الفرق هو في مسلكيتهم تجاه رعاياهم وفي تلك الكنيسة الجديدة، رسم سمعان شماساً وفي أول عام رسم كاهناً، وفي تلك الأيام كانت هناك موجة نزوح كبيرة من مسيحيي المنطقة من الأرثوذكسية إلى البروتستانتية”.
الانشقاق من الرواية إلى الواقع: ثورة خليل السكاكيني:
موجز تاريخي
كيف تمكن 1% من اليونانيين من السيطرة التامة على كنيسة تضم 99% من رعاياها عرب، وجذورها التاريخية عربية، وأملاكها وسياق توسعها وبيئتها عربية؟
يتحدد مفهوم الكنيسة بحسب العقيدة الأرثوذكسية من مجموع المؤمنين من رعية وإكليروس (رجال دين)، وبما أن حوالي 99% من هذا المجتمع هم من العرب، فلابد من تصحيح مفهوم “تعريب الكنيسة” لأن هذه الكنيسة عربية أصلاً، وإنما الحديث يدور حول استرداد الكنيسة من مغتصبيها الأجانب، حتى لو تم ذلك برداء الدين، وتحت شعارات الطقوس الروحية والأسرار الكهنوتية.
ولا يجب أن يخطر على بال القارئ بأي شكل من الأشكال أن يكون هذا النص تدخلاً في الجانب العقيدي للكنيسة، أو اعتداءً على خصوصيتها، أو ضرباً من الشوفينية القومية، إذ يرى هذا النص على العكس من ذلك أن الخصوصية العربية للكنيسة الأرثوذكسية تم انتهاكها لأسباب سياسية في الأساس، وتم مصادرة الكنيسة في سياق استعماري للهيمنة والاستثناء، فكانت هناك هيمنة عرق معين على الكنيسة ضمن بيئة الحكم العثماني في البداية، لمصالح تتعلق بالتحالفات وشراء الولاءات، واستثناء العنصر العربي، لأهداف تتعلق بالإخضاع والنفوذ.
ولتتبع هذا الاستحواذ، لابد من الغوص عميقاً في تاريخ حي الفنار الإسطنبولي، ونفوذ الأرستقراطية اليونانية هناك، وتمكنها من بسط نفوذها بالمال وشراء الذمم والتحكم بالاقتصاد على كبار موظفي الباب العالي. تتفق المراجع بـأن” الأرثوذكسية Orthodoxy” كلمة مركبة من لفظتين يونانيتين «أرثوس»، وهي صفة لما هو قويم وسليم و”ذكساً” وهي اسم يدل على الرأي والمعتقد والفكر. فيكون معنى الكلمة اليونانية المركبة “أرثوذكسية” هو المعتقد القويم أو الرأي القويم[11].
“وتطلق كلمة أرثوذكسية، لغةً، على ما يوافق كل تراث، دينياً كان أم غير ديني. وتطلق اصطلاحاً على جماعة كبيرة من المسيحيين الذين يقولون إنهم حافظوا على المعتقد الصحيح كما حددته المجامع المسكونية (المجمع المسكوني مؤتمر يُدعى إليه أساقفة العالم كله للتداول في شؤون الكنيسة)، تمييزاً لهم من الذين عُدّوا “هراطقة”. وفي معظم الأحيان، يُطلق الأرثوذكس على كنيستهم أسماء “الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية الشرقية” أو “الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية في الشرق” أو “الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة”، ذلك أن كلمة الكاثوليك تعني “الجامعة” أو العامة، على أنه من الضروري أن لا تؤدي هذه التسميات إلى اللبس، فالكنيسة التي تعد نفسها الكنيسة الجامعة الحقيقية، ليست جزءاً من الكنيسة الكاثوليكية “الرومانية”. ومع أنها تسمى “شرقية”، فهي لا تقتصر على العالم الشرقي، ويطلق عليها إيجازاً «”الكنيسة الأرثوذكسية”.
ثمة أسرتان من الكنائس في يومنا تقعان تحت مسمى “الأرثوذكسية”: الشرقية غير الخلقيدونية (التي رفضت قرارات مجمع خلقيدونية الذي انعقد في العام 451م)، وتضم الكنيسة الأرمنية والكنيسة السريانية (كنيسة اليعاقبة) في سورية والهند، والكنيسة القبطية في مصر وإثيوبية، والكنيسة الخلقيدونية، وتضم الكنائس الأربع القديمة في القسطنطينية والاسكندرية وأنطاكية والقدس، والكنائس الحديثة في روسية ورومانيا وبلغاريا وصربيا وجورجيا، فضلاً عن الكنائس المستقلة في قبرص واليونان وألبانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا”[12].
كانت الأرثوذكسية في فلسطين عربية مائة في المائة، تستمد مادتها البشرية من العرب الأقحاح من الغساسنة والمناذرة العرب، وتأسست الكنيسة المقدسية حسب السجلات الكنسية على يد يعقوب الرسول ابن يوسف النجار، وتوالى على رئاسة أسقفية القدس والأراضي المقدسة (التي تحولت لاحقاً إلى بطريركية في ظرف سياسي مرتبط بانتقال أو عودة المقر البطريركي إلى القدس) العشرات من الأساقفة والبطاركة؛ غالبيتهم الساحقة كانت من العرب أهل البلاد، وآخرهم كان البطريرك عطا الله الذي رسم بطريركاً عربياً عام 1516م وكلهم عرب[13]. وكان للبطريرك عطا الله الفضل في إنشاء مؤسسة الوقف، الكنسية الأرثوذكسية، باستحصاله على فرمان من السلطان سليم عام 1517 منحه فيه حق بناء كنائس جديدة وترميم القديمة والمزارات ما أسس لعهد الأوقاف.
لعبت الحروب الصليبية دوراً حاسماً في انتقال البطريركية من القدس إلى القسطنطينية، ليس بسبب هذا الانتقال بالذات، بل بسبب التبعات السياسية اللاحقة، والتي أدت فيما بعد إلى سيطرة اليونانيين على الكنيسة، حيث يتبع الفرنجة “الصليبيون” الذين احتلوا القدس عام 1099 لطائفة اللاتين، وتعاملوا مع الأرثوذكس كعرب، وساووا في قمعهم بينهم وبين المسلمين، ما يعكس الجوهر العرقي الاستعماري الحقيقي لتلك الغزوات. وكما نصبوا ملوكهم وقادتهم العسكريين على إقطاعات البلاد ومدنها، نصبوا أيضا قساوستهم وبطاركتهم اللاتين على القدس، واحتلوا دار البطريركية الأرثوذكسية فيها، وطردوا البطاركة الأرثوذكس إلى القسطنطينية، واستولوا على كنيسة القيامة والعديد من الكنائس والأديرة العربية الأرثوذكسية.
وعندما فتح العثمانيون القسطنطينية سنة 1435، تركوا للمسيحيين حرية العبادة، وسمح السلطان بانتخاب بطريرك جديد، سمي “ملة باشي” رئيساً للمسيحيين جميعاً، وقد تجاوز نفوذه حدود بطريركيته وسلطاته الدينية إلى نفوذ سياسي كبير، بعد أن منحه السلطان المزيد من الامتيازات وتمكن من بسط نفوذه على عموم الكنيسة الأرثوذكسية.
وكان للنظام العثماني الجديد آثار ملحوظة على الكنائس القديمة في حوض البحر المتوسط والبلقان، فالدعم الذي منحه العثمانيون لأسقف القسطنطينية، الشخصية الإدارية الرسمية «لملة الروم»، زاد من سيطرة اليونانيين على هيئة الكهنوت، فشغل الأساقفة اليونان مراتبها المتسلسلة كافة، وأصبحت البطريركيات القديمة في الشرق الأوسط تخضع لسلطة الفنار[14] (حي في إسطنبول أقيمت فيه البطريركية الأرثوذكسية). كما أن الكنيستين البلغارية والصربية انتهتا إلى المصير نفسه، إذ فقدتا رسمياً آخر مزايا استقلالهما على يد بطريرك القسطنطينية صموئيل هانتشرلي.
الفنار كمركز إمبراطوري لليونانيين
يعدّ حي الفنار في إسطنبول “القسطنطينية” مركز بطريركية القسطنطينية؛ المركز العالمي للأرثوذكسية الشرقية. ظهر نفوذ هذا الحي بسبب الثروة الهائلة التي امتلكتها العائلات اليونانية التي تسكنه، وكان لهذه العائلات دورٌ في الصراع المحتدم مع القيصرية الروسية والحرب بينها وبين العثمانيين التي حصلت على تغطية عقائدية من الكنيسة، فأغدق العثمانيون بالامتيازات والمناصب على اليونانيين لشراء ولائهم وفصلهم عن روسيا.
في ذلك الوقت، كانت القدس تمثل مركزاً لرمزية الهيمنة بين القوى العظمى المتغطية بأردية الدين. وليس من الغريب بالتالي أن الكنيسة الأرثوذكسية لعبت دوراً أساسياً في الحرب الروسية –العثمانية التي انتهت عام 1774، بمعاهدة كيتشوك كينارجي[15]، والتي منحت الروس السيطرة على شبه جزيرة القرم وجعلتهم للمرة الأولى شركاء في البحر الأسود، وأسست لدورهم الكنسي في المشرق والقدس على وجه الخصوص. وليس من الغريب أن نقرأ في صفحات التاريخ أيضاً أن حرب القرم التي تطورت إلى صدام دولي، وكان من الممكن أن تكون هي الحرب العالمية الأولى، والتي انتهت بهزيمة الروس سنة 1856، كانت قد اندلعت بفعل خلاف فرنسي –روسي (كاثوليكي- أرثوذكسي) للسيطرة على كنيسة القيامة في مدينة القدس.
جرمانيوس والإزاحة العرقية
بالعودة إلى التسلسل التاريخي، نرى أن عهد البطاركة العرب انتهى باستقالة آخرهم عطالله المعروف باسم دروتانوس الثاني عام 1534م، حيث أُنتخب البطريرك الجديد -جرمانيوس اليوناني- الذي كان يجيد اللغة العربية التي درسها في مصر إجادة تامة وظل بطريركاً لحوالي 45 عاماً[16].هذه الفترة كانت كافية تماماً في ظل المحاباة المركزية في اسطنبول ونفوذ الفنار، ليعمل جرمانيوس، العنصري، المناهض للاكليروس العربي على تحويل الرئاسة الروحية للكنيسة إلى يونانية بالكامل، عبر حصرها بالعنصر اليوناني فقط، فأنشأ منظمته الخاصة التي ساعدته على تنفيذ أغراضه وهي (أخوية القبر المقدس)، فما هي هذه الأخوية الغامضة؟
تدعى “أخوية القبر المقدس اليونانية” لاقتصار عضويتها على العنصر اليوناني فقط، فلا يمكن ضم أي عضو من عرق آخر إليها. وهي تعتبر الكنيسة بكل ما تعنيه وتملكه ملكاً خالصاً للأمة اليونانية، ما يجعلها تخرج من إطار الدين إلى إطار السياسة والطمع الاستعماري. تأسست الأخوية في عام 1534 بواسطة الراهب اليوناني جرمانوس البيلوبونيسي، وقامت على فكرة العرق اليوناني. وقد ذكرنا الدور العظيم الذي لعبه رهبان الفنار في تقوية وتمكين هذه الأخوية ليصار إليها السيطرة الكاملة على الكنيسة الأورشليمية، بمعزل عن الأرثوذكس الوطنيين. وكانوا لضمان الهيمنة، قد أصدروا قانوناً أقره السلطان بجعل خلافة الكرسي البطريركي وراثياً، من الأب إلى الابن أو ابن الأخ. وبقي هذا حتى عهد البطريرك كيرللس، الذي وجد أن ضعف الطائفة الوطنية لا يخولها النهوض للتنافس في الانتخابات، فأعادها على أن تكون محصورة فيهم فقط.
دأب جرمانيوس بمجرد توليه الكرسي البطريركي على “يوننة” الإكليروس بكليته، فنصّب رجل دين يونانياً مكان كل عربي متوفى. وبعد تقدمه في العمر، اخترق نظام الانتخابات وأكمل عملية الإزاحة، التي كان ربما يخشى عليها أن تتوقف، فاتخذ إجراءً استباقياً برسم البطريرك الشاب صفرونيوس عام 1579 م خليفةً له، على غير رغبة المجتمع الأرثوذكسي العربي. ويمكن اعتبار اجتماعات وإرهاصات ذلك الزمن البعيد عام 1579 لمحاولة منع تنصيب صفرونيوس اليوناني هي الإرهاصات الأولى لما نسميه اليوم استناداً إلى المعلم خليل السكاكيني “النهضة الأرثوذكسية” ومسار الكفاح لتعريب الكنيسة.
ابتلع العرب تنصيب صفرونيوس مؤقتاً، على أمل أن يأتي عربي في مكانه غير أن خلفه كان ابن أخيه ثيوفانس؛ يوناني آخر وصل إلى الكرسي عام 1608 بدعم من السلطان العثماني إبراهيم، الذي لم يثبته في المنصب فحسب، بل سجن ونفى معارضيه العرب. خطا هذا اليوناني العنصري كأسلافه خطوة لم يكن جرمانيوس وصفرونيوس قد تجرأ عليها بعد، عبر “قوننة” إجراءات إزاحة العنصر العربي، فوضع قانوناً غاشماً لا يسمح لأي من أبناء الكنيسة المقدسية الأرثوذكسية الوطنية بالوصول إلى أية درجة من الدرجات الأكليروسية أو الرهبانية.
وكان لابد للأخوية المذكورة أعلاه أن تقونن ذاتها وقوانينها، فكان دستورها عام 1699 الذي وضعه البطريرك ذوسيثيوس الذي تولى المنصب عام 1644، وهو كما سنرى في تفاصيله يحظر قبول أي عربي أرثوذكسي من فلسطين وشرق الأردن في عضويتها وانتخاب بطريرك أو مطران من غير رجالها، وهم طبعا من الأمة اليونانية حصرياً.
دستور “أخوية القبر المقدس”
“متى جاء العرب إلى هنا؟ اليونانيون هنا منذ أكثر من 2000 سنة، ولقد وصل العرب فقط خلال القرن السابع، هذه هي كنيستنا؛ كنيسة اليونانيين، إذا كانوا لا يقبلون قوانيننا فليس لديهم بديل سوى اختيار كنيسة أخرى، أو أن يؤسسوا كنيسة لهم.”[17] بهذه الكلمات، التي يخيل إلى القارئ أن قائلها هو الحاخام العنصري عوفاديا يوسف، يجيب البطريرك ديودوروس على سؤال صحيفة “هآرتس” يوم 2 أيلول/سبتمبر 1992، مستنكراً استنكار الفلسطينيين بيع الكنيسة لأملاك الوقف.
وهذا القانون؛ قانونهم الذي يتحدث عنه هذا البطريرك، وتتبع البطريركية والسينودس تعاليمه بحذافيرها، هو قانون أخوية القبر المقدس، الذي صاغه ذوسيثيوس. ويستوجب هنا عدم الخلط بينه وبين “قانون البطريركية الرومية الأورشليمية” الذي وُضع سنة 1875 وتم تعديله عام 1957، ثم مرة أخرى عام 1958، رغم أن الأخوية كانت لها اليد الطولى في صياغة هذا القانون وتعديلاته[18].
ويتكون دستور الأخوية الذي يحدد امتيازاتها ومنافعها في الكنسية من 13 بنداً؛ وهو قائم على أرضية الاستعلاء والهيمنة. وفيما يلي أهم هذه البنود[19]:
البند رقم (1) يُصادِر الكنيسة بلا أدنى ريب وجميع أملاكها وحتى القبر المقدس لصالح الأمة اليونانية، ونصه “يتبع القبر المقدس وجميع ملحقاته وسائر مزارات فلسطين وأديرتها وكل المؤسسات الخيرية في فلسطين وخارجها للبطريرك رئيس الأخوية وهي جميعها ملك للأمة اليونانية”
البند رقم (2) يحيل كل استثمارات واقتصاد الكنيسة إلى بطريركها كمتسلط وحيد، يقود وحدة رهبانية خاصة جميعها من اليونانيين بالطبع، ونصه: “يكون القبر المقدس وجميع ملحقاته وحدة رهبانية ديرية، متماسكة، تتمتع بنوع من الاستقلال الإداري، لاستثمار أموالها، بإشراف البطريرك رئيسها”.
البند رقم (4) يؤكد على ملكية القبر المقدس للأمة اليونانية التي لها الحق فقط في أن يكون الرهبان منها، ونصه “بما أن القبر المقدس وتوابعه يتبع البطريرك الأورشليمي اليوناني، فإنه ملك للأمة اليونانية، ومن هذه الأمة تختار الأخوية رهبانها حسب أنظمتها وقوانينها”.
البند رقم (7) نصه: “إن النذور والتقدمات والهبات الموقوفة للقبر المقدس والمزارات والأماكن المقدسة الأخرى هي ملك للأمة اليونانية”.
البند رقم (11) ونصه: “للأخوية حق الملكية لكامل أموالها في فلسطين وخارجها، ويمكنها التصرف بها بكامل حريتها ومطلق رغبتها”
البند رقم (13) رغم أن الأخوية حازت على كل شيء من الكنيسة حتى عظام موتاها، إلا أن لاشيء يلزمها بإنفاق أي شيء على احتياجات الكنيسة، ونصه: “تقدم الأخوية في حدود إمكاناتها ومواردها وبكامل حريتها وبدافع من الالتزام الأدبي فقط الأموال الضرورية لترميم الكنائس القائمة وبناء أخرى جديدة”.
استمر تعاقب البطاركة والمطارنة اليونان حتى نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً عند الأزمة التي طالت الكنيسة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، نتيجة الصراع المذكور بين روسيا واليونان، خصوصاً الأخوية اليونانية التي استبد بها الجزع بعد استقلال البطريركية البلغارية والصربية، وقررت القتال حتى النهاية لإبقاء الاستحواذ على أنطاكية والقدس. اشتد الصراع حين عزل المجمع المقدس البطريرك كيرلس بحجة علاقته بروسيا الأرثوذكسية وتأييده لها واستبدل بالبطريرك بروكوبيوس الثاني عام 1873م. وتشهد تأريخات هذه الفترة آراءً متناقضةً حول البطريرك المخلوع والمعين، تتبع أهواء ومصالح مطلقيها[20].
لاحقاً، تأسست “الجمعية الأرثوذكسية الوطنية” رداً على عملية العزل، وزعم اليونانيون أن الروس أججوا النزعة القومية عند العرب، وشدوا أزرهم في معاداة الأخوية، وأرسلت الجمعية وفداً إلى الأستانة احتجاجاً على سلوك الأخوية وعزل البطريرك. ونذكر أن سلاح العزل هو السلاح الأقوى بيد الأخوية لمعاقبة البطاركة الذين يخرجون عن قانونها والمسلك الذي ترسمه، وكان الوفد مؤلفاً من ينابوت الصوابيني وحنا زكريا وسمعان المشبك.
وتذكر بعض المصادر أن الدكتور جورجي صروف قد قاد الوفد الفلسطيني، والذي كان ترجمان القنصلية الروسية في القدس، وعزله الروس فيما بعد من منصبه لإخفاقه في تعبئة الرأي العام لدعم البطريرك كيرلّس. لكن الوفد فشل في مهمته وعاد بخفي حنين، واستمر الاشتباك بين الجانبين لحين صدور (قانون البطريركية الرومية الأورشليمية) المذكور أعلاه. ويمكن القول إن هذا القانون الذي تستمد عناصره من دستور الأخوية المشروح أعلاه مجحف تماماً بحق العرب، وأدى إلى اشتعال النزاع بدلًا من إخماده، إذ إن الغلبة رغم كل التحقيقات ولجات التحقيق كانت لليونانيين الذين أحكموا إطباقهم على الكنيسة، واعتبروا سيطرتهم عليها مسألة حياة أو موت بعد إخفاقهم في استمرار الحيازة على بطريركيتي صربيا وبلغاريا.
إن بقية ما حدث والصراع المستمر حتى اليوم هو جزء من التاريخ الذي لا داعي لإدراجه هنا، بل يكفي القول إن هذا التاريخ يعكس طبيعة الأخوية اليونانية وطبيعة عملية النهب التاريخي الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية الفلسطينية، وهي أموال الفلسطينيين وخيراتهم التي تذهب إلى جيوب هؤلاء المغتصبين[21].
خليل السكاكيني
يعد خليل السكاكيني من أبرز قادة “النهضة الأرثوذكسية” بل ربما كان هو راعيها الأساسي، وكان نضاله هو استمرار لنضال خمسة قرون لأبناء الطائفة العرب الفلسطينيين في سعيهم لاسترجاع كنيستهم وتعريب قيادتها، وعُرف السكاكيني بجرأته ومجاهرته بآرائه العلمانية ونزعته الوطنية العروبةي. وتركز نضاله على “خلع نير اليونان”، إذ رأى أن لا حق لهم في الرئاسة كنسياً وسياسياً وأدبياً[22].
تمسّك السكاكيني بعروبته ودعا إلى تعريب لغة الكنيسة وتعريب الصلوات، ونشر بهذا الصدد وثيقته التاريخية لنهضة الأرثوذكسية في فلسطين عام 1913. وفي هذا الكتاب، صور خليل السكاكيني حالة الطائفة الأرثوذكسية في القدس وما تعانيه من رجال الإكليروس الأرثوذكسي الديني، وخاصة من البطريرك والرهبان اليونانيين، الذين لا يمتون للنصارى العرب بأية صلة عاطفية أو قومية أو وطنية، ووجه انتقادات مريرة لأسلوب الكنيسة في التعليم. ولكن لعل نقدَه الأهم للكنيسة وللتعليم فيها على حد سواء قرارُه الانشقاق، والخروج مبادراً إلى الأمر قبل أن تقرر الكنيسة حرمانه، بعد أن يأس من الإصلاح وإمكانية الحد من تغول اليونان وتجبرهم، ووصول صدامه مع البطريرك ذميانوس إلى حائط مسدود.
في هذا السياق، يقول السكاكيني: “لاأستطيع أن أكون في الملة الأرثوذكسية بعد اليوم. لا أستطيع أن أكون تحت رئاسة هؤلاء الرهبان الفاسدين المنحطين، ولا من تلك الملة المنحطة.. لست أرثوذكسياً بعد اليوم”.[23]على إثر ذلك، أصدر ذميانوس “حرماً” بحقه، ومنع الرعية من مخالطته والإصغاء إلى آرائه، ثم رفضت الكنيسة تعميد طفله، وأخرجته من المنزل الذي كان يسكنه، وهو منزل تابع لـ«دير الروم» في القدس.
على وقع كل ما سبق، شن السكاكيني حرباً بلا هوادة على الكهنوت اليوناني. وبادلته الكنيسة الحرب بمثلها، واتهمته بالإلحاد والميل إلى البلشفية الشيوعية، مستغلةً صداقته مع بندلي الجوزي، الذي كان يقيم في بطرسبرغ مدرساً في كليتها، ومنخرطاً في الحزب الشيوعي هناك[24]، فأصدر دميانوس الأول مرسوم “الحرمان على السكاكيني من الكنيسة”[25] وقد كان السكاكيني يرى أن أكثر الظواهر مدعاة للعياء في المجتمع الفلسطيني هي سيطرة رجال الدين على الرعية باسم الدين والقداسة، ثم تحكّم رأس الكنيسة بشؤون الناس على طريقة الراعي والقطيع والعصا.
ولما أيقن السكاكيني أن هذا المثال غير جدير بالاقتداء، راح يجاهر بآرائه في رفض الطقوس كلها، وشرع يدعو إلى الأخذ بروح الإنجيل لا بطقوس الكنيسة، وكان يردد قول الإنجيل: “الحرف يقتل والروح يحيي”، ثم قاد حركة إصلاحية داخل الطائفة “الأرثوذكسية” للتخلص من استبداد (الإكليروس اليوناني)، وكان لا ينفك قائلاً: “لا تخافوا السماء لأن سلطتهم (أي سلطة رجال الدين) ليست من السماء”[26].
خاتمة
عادت أزمة الكنيسة الأرثوذكسية على مدى السنوات الأخيرة بعد انكشاف فضائح تسريب أملاك الوقف الأرثوذكسي إلى جمعيات صهيونية ورجال أعمال صهاينة، ما يمهد لتهويدها، وتعميق السيطرة اليهودية في القدس، تمهيداً لفرض وقائع على الأرض تسمح للكيان الصهيوني بتمرير إرادته تجاه مستقبل القدس المحتلة.
ونظراً للاشتباك السياسي المحتدم في وضعية الأوقاف وتسريبها، الذي يشكل خطراً كبيراً على عروبة القدس وغيرها من مناطق التسرب، وتواطؤ البطريرك الحالي والسابق والاكليروس اليوناني على هذا التسريب، تتجاوز قضية الكنيسة الأرثوذكسية ظاهرها الديني الطائفي لتصبح قضية وطنية عامة، ويصبح الكفاح من أجل استرداد الكنيسة من أيدي الاستحواذ اليوناني كفاحاً وطنياً شاملاً، وجزءاً لا يتجزأ من عملية دحر الاحتلال بجميع وجوهه، والتخلص من جميع أشكال السيطرة الاستعمارية المتواطئة على فلسطين وشعبها بجميع طوائفه.
ربما يثير الادعاء بأن حالة الكنيسة الأرثوذكسية هي حالة احتلال وهيمنة سياسية الكثير من الجدل والاعتراض، ولكن لايمكن في أي حال إنكار أن هذه السيطرة جاءت في سياقها التاريخي، ومسارات تفعيلها في سياق سياسي بحت، مرتبط بإطار استعماري، وصراعات هيمنة بين دول ذات طموحات استعمارية، تغطت بغطاء الدين.
إنها لحالة نادرة في التاريخ أن يُقدِم عنصر معين على احتلال مؤسسة دينية، وترسيمها عرقياً، بحيث يكون عنصر مهيمن ومسيطر ويملك كل شيء بدون وجه حق، وعنصر آخر يشكل أصل الكنيسة وجوهرها وتاريخها محروم منها ولا يحوز على أي شي. ولايمكن إيجاد تفسير ديني طبعاً لهذه الحالة، سوى الفكرة الاستعمارية الكامنة في فكر وسلوك “أخوية القبر المقدس” التي تتصرف كمستعمر لا يلقي بالاً لسكان البلاد الأصليين، بل ينطق بلغة استعمارية لا تختلف عن لغة عتاة المتطرفين الصهاينة كما في كلام ديودوروس آنف الذكر.
والحقيقة أنه إذا كان الإكليروس بنية دينية في شكله ووظيفته التاريخية كما يجب أن يكون، فإنه تحول على يد الأخوية إلى بنية استعمارية انتقلت وظيفياً من التبشير والرعاية إلى النهب والسيطرة. لنا أن نستخلص من ذلك أن النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية واستعادتها إلى أصلها العربي الفلسطيني، واستعادة ممتلكاتها المنهوبة هي مسؤولية وطنية لا تقتصر على الفلسطينيين من طائفة الأرثوذكس، بل يُعنى بها كل وطني فلسطيني، بغض النظر عن دينه ومذهبه وفكره، فهذا الصراع هو جزء لا يتجزأ من كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال من كل أشكال الاحتلال والهيمنة والتبعية.
—————————————–
الهوامش:
[1] منظمة تأسست عام 1534 على يد الراهب اليوناني جرمانوس البيلوبونيسي. الذي أصبح أول بطريرك يوناني للكنيسة الأرثوذكسية، في التاريخ، رفعت لواء العرق اليوناني، فلايقبل في عضويتها من لم يكن من الدم اليوناني، ودعمت أول نشأتها من رهبات “الفنار”في اسطنبول لعظيم نفوذهم في الدولة والقطاع المالي، ما ساعد على سيطرتهم الكلية على الكنيسة الأورشليمية، وحصرها في أيادي أعضائها على تأييد اختلاسهم الكرسي البطريركي الأورشليمي وجعله وراثياً حتى زمن البطريرك الأروشليمي كيرللس حينما ألغي الإرث في المنصب وصاروا يعينون البطريرك بواسطة الانتخاب المحصور من أعضاء الأخوية حصرياً.
[2] توفي آخر البطارقة العرب عطا الله، المعروف باسم دروتانوس الثاني، عام 1541، بأفضل التقديرات، وثمة روايتين حول عزله من منصبه، الأكثر شهرة أنه استقال، أو دفع إلى الاستقالة، والثانية أنه تمت إقالته بضغط من اليونانيين، ومؤامرة من جرمانوس والأخوية، وتوفي في االمنفى، ولم نعثر على تفاصيل إضافية.
[3] نشرفي :يوميات خليل السكاكيني (الكتاب الثاني 1914-1918). تحرير أكرم مسلم، مؤسسة الدراسات المقدسية في رام الله ومركز خليل السكاكيني الثقافي. ط1 2004.
[4] زياد قاسم، الزوبعة (رواية). منشورات أمانة عمان الكبرى/الأردن 1996.
[5] زياد قاسم (1945-2007) روائي أردني من أبرز رواد الرواية الأردنية من مدينة عمان، تعود جذوره إلى مدينة صفد الفلسطينية، أول رواياته كانت (المدير العام) ، ألف عدة روايات منها (أبناء القلعة) و(العرين) و(الخاسرون) وأرخ فيها لتاريخ مدينة عمان والمنطقة ، أبرز رواياته (الزوبعة) وهي ملحمة من ستة أجزاء.
[6] شهادة نزيه أبو نضال وردت في: نقاد يعاينون تجربة قاسم الروائية”: www.startimes.com/f.aspx الاسترداد الأخير: 25/11/2017.
[7] وردت شهادة زياد قاسم عن تجربته الروائية في: أفق التحولات في الرواية العربية: شهادات روائيين عرب. جادة الفنون.مؤسسة خالد شومان. عمان/الأردن. بدون تاريخ.
[8] قامت هذه الصراعات في لبنان وسوريا بين الموارنة من جهة والدروز والمسلمين من جهة أخرى. بدأ الصراع بعد سلسلة من الاضطرابات توجت بثورة الفلاحين الموارنة على الإقطاعيين وملاك الأراضي من الدروز. وسرعان ما امتد إلى جنوب البلاد حيث تغير طابع النزاع، فبادر الدروز بالهجوم على الموارنة. والتي تكبد فيها الدروز والمسلمون والمسيحيون خسائر كبيرة.
[9] الإكليروس: كلمة يوينانية الأصل يقصد بها أصحاب الرتب الكهنونية الذين يخدمون شعب الله المؤمنون من أساقفة وكهنة وشمامسة وقد تم تعريب الكلمة عن اليونانية، من كلمة Clergy والتي تعنى (نصيب)، فالاكليريكي أي أحد رجال الإكليروس هو من يقول “الرب هو نصيبى وميراثى”. وجدير بالذكر أن مؤلف المراسيم الرسولية لم يفرق بين تعبيريّ “الإكليروس و”الإكليريكيين فكان يستخدم أيهما محل الآخر ليشير إلى كافة الرتب الكنسية، كبيرها وصغيرها.وعموما طائفة الإكليرس هم ثلاث رتب وهي: الشمامسة والقسس والأسقفية، وهي درجات بدورها.
[10] يذكر الأستاذ وليد الخالدي في كتابه “كي لاننسى” أن المجيدل كانت قرية مختلطة وفيها كنيسة للروم الكاثوليك، ويجب أن يتخيل القارئ الكريم أن شخصية رجا، ليس بالضرورة أن تكون شخصية أرثوذكسية، ولعله إما خطأ من الراوي أو أن الفتى رجا لم يأبه في هروبه وهيامه علىوجهه لأي كنيسة يلجأ.
[11] قاموس المصطلحات الكنسية: https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Orthodoxy-Orsozox.html
[12] الأرثوذكسية: الكنيسة: في الموسوعة العربية: https://www.arab-ency.com/ar/البحوث/الأرثوذكسية-الكنيسة
[13] إميل الغوري، تاريخ القضية الأرثوذكسية في فلسطين. منشور في: http://almoutran.com/2011/04/1247، مسترد يوم 52/11/2017.
[14] لمزيد من المعلومات حول حي الفنار وتاريخ اليونانيين في الامبراطورية العثمانية يرجى مراجعة: http://www.wikiwand.com/ar/اليونانيون_في_تركيا
[15]معاهدة كيتشوك كاينارجي (وتُكتب أحياناً «كوتشوك كاينارجي» أو «كوتشك كاينارجا» أو «كوچوك كاينارجا» أو «كوجك قينارجه» معاهدة سلام بين روسيا والدولة العثمانية المنعقدة في 21 يوليو 1774 في معسكر قرب قرية كيتشوك كاينارجي التي تقع في بلغاريا المعاصرة. جاءت تلك المعاهدة في 28 مادة ومادتين منفصلتين، وقد أورد نصها محمد فريد في كتابه “تاريخ الدولة العلية”، وبمقتضى هذه المعاهدة انفصلت خانية القرم عن الدولة العثمانية، وأصبحت دولة مستقلة، لا ترتبط بالدولة إلا قيام شيخ الإسلام في إستانبول بتنظيم الشؤون الدينية للقرم، ونصت المعاهدة على منح الأفلاق والبغدان (رومانيا) الاستقلال الذاتي تحت السيادة العثمانية، مع إعطاء روسيا حق التدخل في اختيار حكامها، وأعطت المعاهدة لروسيا حق رعاية السكان الأرثوذكس الذين يعيشون في البلاد العثمانية، وكان هذا الاعتراف ذريعة لروسيا في أن تتدخل في شئون الدولة العثمانية. وألزمت المعاهدة أن تدفع الدولة العثمانية غرامات حرب لأول مرة في التاريخ، فدفعت 15,000 كيس من الذهب للروس.
[16] ‘ميل الغوري. سبق ذكره.
[17] جهاد أبو ريا،. ملاحظات على طريق تحرير الأوقاف الأرثوذكسية في فلسطين. منشور في: http://www.almayadeen.net/files/794278/ملاحظات-على-طريق-تحرير-الاوقاف-الارثوذكسية-في-فلسطين
[18] للمزيد حول قانون 1875، وانتهاء العمل به وتعديلاته وظروف الصراع الروسي اليوناني على الكنيسة الأورشليمية: د. الأب: حنا سعيد الكلداني. المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطين . الباب الأول: البطريركية الأورشليمية الأرثوذكسية. منشور الكترونيا على الرابط التالي : http://www.mansaf.org/fehrest.htm
[19] اعتمدت هنا على نسخة الدستور التي نشرها الباحث أليف صباغ على صفحته التواصلية على موقع الفيس بوك، وعالج بعض نقاطها في: : أليف صباغ. القضية الأرثوذكسية الوطنية. مجلة قضايا إسرئيلية عدد (61). مركز مدار . أيار/مايو 2016.
[20] حنا سعيد الكلداني. سبق ذكره.
[21] لمراجعة معمقة لواقع الكنيسة الأرثوذكسية في القرن العشرين وأدوار الاحتلالين البريطاني والصهيوني، والدور الأردني، يمكن مراجعة : أليف صباغ. سبق ذكره.
[22] فوزي الأسعد، خليل السكاكيني. مكتبة الجمعية العلمية،نابلس 1994. ص18
[23] المصدر السابق. ص21
[24] د.محمد عيسى صالحة. أعلام مقدسية. في: دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس. تحرير د.محسن محمد صالح. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. ط1بيروت 2000. ص.65.
[25] يوسف أيوب حداد. خليل السكاكيني،حياته،مواقفه. آثاره . منشورات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. دمشق 1981.ص48.
[26] جميع المقتبسات من خليل السكاكيني مأخوذة من: يوميات خليل السكاكيني: يوميات-رسائل-تأملات/الكتاب الثاني.: النهضة الأرثوذكسية،الحرب العظمى ،النفي إلى دمشق (19114-1918). تحرير أكرم مسلم. منشورات مركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة الدراست المقدسية. طبعة أولى 2004 (الفصل الأول: النهضة الأرثوذكسية : الأسرة و”المدرسة” الصفحات: 3—94).